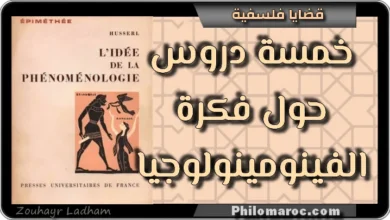إشكالية الحداثة في عالم ما بعد الحداثة! خالد الحسيني
خالد الحسيني
يحاول هذا البحث المتواضع إعادة التفكير مرة أخرى في أسئلة محرقة، ما فتئت تتكرر في عدد كبير من الدراسات والمقالات، التي اهتمت بالفكر الغربي الحديث/المعاصر وهي:
ما الحداثة وما بعد الحداثة؟
إن إعادة تكرار هذه الأسئلة، لا يعني اجترار ما قيل، وإنما محاولة اجتراح وفتح كوة في بعض مهمشها، واستجلاء مغيبها، وقبل التسلل إلى افتضاض سراديب هذه القارة المعتمة، يبدو أنه من الأحرى الإماءة إلى أن ظهور الحداثة كسؤال فكري، وكمشروع حضاري ضخم، مرتبط ارتباطا أنطولوجيا بالفكر الغربي، وتعبيرا صادقا عن قيمه وتصوراته، وعن موقعه من مفهوم الزمن والمكان والإنسان، كما تعتبر الحداثة نبتة طبيعية أينعت في تربة خصبة مخصصة، ليست دخيلة عليها، الشيء الذي أعطاها شرعية أو مشروعية قوية، لكونها لصيقة بدينامية المجتمع الغربي الحديث التاريخية منذ تشكيله إلى مرحلتنا الراهنة.
في ظني، قبل أن نلج إلى عتبة السمات العامة التي تميز هذا المشروع الحضاري أو هذا النموذج الكوني كما يحلو للبعض تسميته، لا بد من الارتكاز على القرن 15 الأوروبي، قرن بوادر وإرهاصات الحداثة في أوروبا الغربية. وكما نعلم، فإن للحداثة تواريخها وجغرافياتها، مثلما أن لها سيلانها الخاص، فقد بزغت بذرتها الأولى في إيطاليا، خاصة في عصر النهضة، حيث وقعت ثورة كوبرنيكية في شتى المجالات، وفي كل مظاهر الفنون والآداب والعلوم، وواكبت أحداث تاريخية هامة كالاكتشافات الجغرافية، والإصلاح الديني، كما قامت حركة النهضة باستعادة فكر اليونان وفكر روما القديمة.
بفضل دينامية الحداثة المتزايدة، وطبيعتها التوسعية بوتيرة سريعة، فدرست إلى كل من فرنسا وألمانيا وإنجلترا، من خلال هذا السيلان الكثيف للحداثة في أوروبا الغربية، أخذت تدريجيا تكتسب بعدا كونيا، وتتخذ بالتالي صورة حداثة مرجعية.
ولم تشرع الحداثة الغربية في تلمس الوعي بذاتها، إلا بعد انقضاء ما يقارب ثلاث قرون على انطلاق ديناميتها في أوروبا الغربية، أي ابتداء من القرن 18 الأوروبي، الذي عرف بعصر الأنوار أو التنوير، عصر انتصار قيم الحرية والعدالة والديموقراطية والانفتاح أي عصر انتصار الفكر الفلسفي الحر الذي يحاول جادا تعرية واستبانت تهافت المؤسسة الكنسية وتقويض وتفكيك أخلاقيات الميتافيزيقا وما تحمله في طياتها من أساطير وخرافات التي تكبل تفكير الإنسان الأوروبي وتقيد عقله، فنادت فلسفة الأنوار بإعطاء الأولوية القصوى للعقل حيث يقول كانط مجيبا على سؤال ما الأنوار: “إن معنى الأنوار خروج الإنسان من تبعيته وإمعيته، أي أن يملك الإنسان شجاعة استخدام عقله بنفسه”
وبالقيام بنقد لاذع لكل الأشياء والظواهر والمؤسسات والمفاهيم، وبإخضاع كل هذه الموضوعات لمحك العقل، لأنه سيد العالم حسب هيجل، غير أن فلسفة الأنوار لم تكتف بالإيمان بقدرة العقل على اختراق الحدود التي فرضتها المؤسسة الكنسية والهيمنة اللاهوتية، بل تعترف له بقوته على تنظيم الحياة، ولم تعز مهمة النقد لهذا العقل بصورة عشوائية واعتباطية بل كان “كانط” يرى أنه “يتعين على كل شيء أن يخضع لمحك النقد” إلى درجة أن هناك من اعتبر هذا القرن “قرن النقد”.
هذا النقد ارتبط بحركة دينية وفلسفية شاملة، ابتدأت في أوروبا عامة وفرنسا خاصة، وهذا لا يعني أنها كانت منحصرة على الفلاسفة فقط، مصطلح فلسفة الأنوار، إنما يعني في العمق انبعاث الروح النقدية والتجديدية من رماد العصور الوسطى، تلك الروح التي شملت المقالات الفكرية الفلسفية والتآليف الموسوعية والإبداعات الشعرية الأدبية التي عملت بالشعار الكانطي القائل:
“لنتسلح بالشجاعة الكافية حتى يعمل كل واحد منا عقله في كل ما هو مدعو إلى بحثه”.
“لنتسلح بالشجاعة الكافية حتى يعمل كل واحد منا عقله في كل ما هو مدعو إلى بحثه”.
وقد استدعى هذا المطلب من بعض المفكرين الاعتماد على النقد والمحاكمة، وعلى تحرير العقل من الأوهام والأساطير، وهكذا وجدنا “فولتير” يصيح صيحة مزمجرة في وجه الكنيسة ويدعو إلى التمرد عليها، مبلورا مفهوما أو منظومة فكرية سياسية تقوم على مفهوم الحرية، وعلى نفس الخطى نجد “روسو” في كتابه “العقد الاجتماعي” يدعو إلى المساواة و”هيوم” في إنجلترا يدعو إلى التسامح.
على الرغم من القيم التي غرسها فلاسفة الأنوار بخصوص التحرر والمواطنة والمساواة والديموقراطية وحقوق الإنسان فضلا عن تكريس مقاييس العقل والعلم والنقد، فقد قام الفكر الفلسفي الغربي بتغييب كل الكلمات الإنسانية الطبيعية الأخرى من أهواء وخيال لاعتباره لها مصدرا للخطأ وعنصرا مشوشا على المعرفة الحقة والذي أضحى بتعبير “باسكال” مجنون المسكن أو مجرد أفكار غامضة كما هو الأمر عند “ديكارت”.
من هنا يبدو أن مبدأ العقلانية أضحى البؤرة المحورية والمركز لفلسفة الأنوار وبموازاة مع ذلك ذهب “هيجل” إلى حد تأليه العقل، إن إشكالية الحداثة وما بعد الحداثة أضحت اليوم قطب الرحى في الفكر الغربي المعاصر، كما أفضت إلى نقاشات وجدالات لا تخلو في بعض الأحيان من الاصطدامية والحدة وتارة أخرى تتسم بالهدوء ورباطة الجأش، وتتمحور هذه الجدالات حول تساؤلات ملحاحة منها أولا ما معنى الحداثة وما بعد الحداثة؟ وهل من الممكن وضع تعريف لمفهوم الحداثة أو إعطاء جواب عن سؤالها؟ وهل فعلا انتقلنا من عصر الحداثة إلى عصر ما بعد الحداثة؟ فهل بمقدورنا تحديد الظروف والعوامل التي قادتها إلى هذا التحول؟ وكيف تعاملت الحداثة وغفل الحداثة مع القضايا الكبرى كالإنسان والزمن والطبيعة؟ والمتأمل لهذه الأسئلة يلاحظ أنه بإزاء مشاكل خلافية يصعب حلها فالمفكر الأمريكي “ريتشارد رورتي” يلحق الحداثة بفكر ديكارت القرنان 16 و17 الميلاديان، والمفكر الألماني “يورغان هابرماس” بربطها بعصر الأنوار القرن 18، أما، الناقد الأدبي الأمريكي” فريدريك جامسون” يحدد تاريخ ميلادها في النصف الأول من هذا القرن.
وإذا كان هذا الأمر يدل على شيء فإنما يدل على التباس مفهوم الحداثة واضطراب معناه وانفراط فحواه، بديهي أن طرح سؤال الحداثة لصيق بتاريخ الأفكار الغربية إلى درجة أن هناك من يعتبر الحداثة مرادفة لفكر الغربي، وتعبيرا بشكل جلي عن قيمه وتصوراته، وعن موقفه من العديد من القضايا الحساسة المحيطة به، فغموض مفهوم الحداثة يؤثر على دلالة مفهوم ما بعد الحداثة، فيرد هذا المفهوم غامضا رخويا علاميا بسبب استناده إلى الحداثة وانبنائه عليها. إذن تبقى ظهور فكرة الحداثة كمفهوم عائم وفضفاض “ترفض كل تعريف أي كل تحديد” وكمشروع ضخم مرتبط ارتباطا وثيقا بالسياق الثقافي للغرب أي بالعقلانية الغربية بحيث لا ينظر إلى تجارب الآخرين إلا صورة مستنسخة لنماذج الغرب، مما جعل الحداثة عبارة عن نموذج كوني لا يعمل الآخرون إلا على إعادة إنتاج عناصره، فالتحديث مع التغريب كما يقال.
فاقترنت الحداثة بالتجليات الأساسية لانتصار العقل الأداتي وسلطته مما أدى إلى الشطط في استعمال العقل والدعوة إلى حياة ميالة إلى التجريد ونافية كل ما من شأنه أن يذكرها بالرغبات الجسدية والنوازع الطبيعية، الشيء الذي أدى بالحداثة إلى ولوج مرحلة الأزمة والتوتر. ويرى “هنري لوفيفر” أن الحداثة لا يمكن أن نواصل مسيرتها بدون أزمات، لأنها تختزن في ثناياها احتمالات الأزمة، وتبدو وكأنها عناصر مؤسسة للحداثة، وهذا ما يفسر كون الفكر الغربي عاد في المرحلة الثانية إلى مرحلة ما تسمى بمرحلة المراجعة والتصحيح إلى إخضاع المطلقات السابقة للنقد، فمارست النقد الذاتي حتى تستطيع تصحيح المسار وتثبيت الأصول، والسير بالفكر الحداثي إلى طريق النجاة. وقد طرح “ألان تورين” “الحداثة كمخرج من الحداثة التي انكشفت عن أزمات كبرى”. حيث همشت الجسد فاعتبرته ثانويا وهامشيا مما أدى إلى الانغلاق على الذات والانكماش عليها وإقصاء الغير، هكذا نشأت نرجسية العقل الغربي التواقة إلى إرادة السيطرة وإرادة القوة، بل إن الرغبة الجامحة والجارفة إلى الهيمنة تقوده وتوجهه مع عدم امتلاك الشجاعة الكاملة للإعلان أن لا وجود لعقل شامل.
وبالنسبة للمقاربات النقدية التي توجه إلى الحداثة ما هي في الواقع إلا محاولة لتكريس مشروع الحداثة ذاته بسبب انغلاقها على ذاتها وعدم فتحها أفاقا لدى مشروع آخر محتمل، وحتى تستطيع أن تنعم بالديمومة والاستمرارية وأن تبقى معاصرة contemporaine كما يقول “بودريار”.
نجد “هابرماس” حين أقدم على نقد الحداثة باعتبارها لم تستغل كل إمكانياتها استغلالا تاما فإنه يقر بأن الحداثة “مشروع لم يكتمل بعد” فإنه تجدد مستمر وسيرورة لا متناهية. ونلاحظ كذلك “أودماركفارد” يذوذ عن الحداثة بقوة حيث يرى أنه عندما ندعو إلى ترك الحداثة فإننا ندعو إلى ترك مكتسبات عصر الأنوار ومن هنا يقول كفانا من الخطابات الترهيبية والمأتمية، ويحث على المحافظة على مكتسبات عصر التنوير بتنبيه “نظرية التوازنات الاجتماعية” والتي يمكن أن نطلق عليها “نظرية التعويض” بمعنى أن التوازن والتكافؤ والتقليص من حدة الصراع بين الأطراف مبدأ الحكم من العلاقة بين النزاعات الفلسفية في كل عصر.
هكذا يرى “أود ماركفارد” في عصرنا الحديث الممتد من القرن 18 إلى اليوم، نموذج عصر التوازن وتجسيد النظرية التعويض، من هنا يتضح بجلاء أن التيارات التي أخضعت الحداثة للنقد بهدف الحد من الأزمة والتوتر قد نجحت إلى حد ما من رد الاعتبار للحداثة.
لكن هناك الإخوان “بومة”، “غرنوت وهارتموت بومة” قد وقفا موقفا وسطا فشبها الحداثة بالعملة إذ هي ذات وجهين متعارضين: وجه إيجابي ووجه سلبي، فالوجه الأول يتجلى في ظهور العقلانية وسيادة قيمها في جل مظاهر الحياة العصرية، وأما الوجه الثاني فيتمثل في تهميش كل ما يمس بصلة بالرغبات الجسدية والأهواء والخيال والمتخيل والنوازع الطبيعية. هكذا تبقى الأزمة مطروحة وبإلحاح “ستظل تستمر وتتعمق وتنتشر كما أن عناصر جديدة ستحاول الدخول في خضمها وتعديلها، وفي النهاية فإن حقبة أخرى ستبدأ مع القرن 21”.
ولهذا السبب برز في تاريخ الأفكار الغربية مفهوم ما بعد الحداثة عند المؤرخ البريطاني “توينبي” 1959 فجعله يدل على علاقات ثلاث ميزت الفكر والمجتمع الغربيين بعد منتصف هذا القرن وهي:
اللاعقلانية والفوضوية والتشويش. وبعد ذلك نقل هذا المصطلح إلى مجالات متعددة كمجال العمارة والرقص والمسرح والتصوير والسينما والموسيقى ومجال النقد الأدبي للتأسيس على تسطح الحركة الحداثية، وهكذا يأتي هذا المفهوم غامضا فضفاضا بسبب استناده إلى مفهوم الحداثة وبسبب توظيفه وإطلاقه على أمور متناقضة إلى الحد الذي يصير معه فاقدا للمعنى ومستغلقا بكيفية مضاعفة، أكثر من ذلك ترك السؤال مطروحا بإلحاح حول عصر ظهور ما بعد الحداثة وأماراتها معلقا، إلى درجة أن هناك من رفض حتى القول بمجيء عصر ما بعد الحداثة، ومنه من قال بتحققه على مسرح التاريخ.
فنجد الناقد “جامسون” يصف ادعاء ما بعد الحداثة بالنظرة الفصامية تجاه المكان والزمان، التي أفرزتها هيمنة القوى الرأسمالية المتعددة الجنسيات المستشرية في أعماق الحياة المعاصرة. كما نجد “هابرماس ينحو نفس المنحى فيعتبر عصر ما بعد الحداثة ردة فعل محافظة ويائسة ضد التنوير.
هذا لا ينفي أن هناك من دافع عن عصر ما بعد الحداثة كما هو الحال مع “جان فرنسو ليوتار”، الذي اعتبر هذا العصر نهاية النظريات أو “الحكايات الكبرى” أي موت المذاهب الكبرى التي تتخذ شكل منظومات مستغلقة أو متقوقعة في شرنقتها نموذجها الإيديولوجيات الكبرى، تفسر الواقع تفسيرا توتاليتاريا.
كما نجد ثلة من الفلاسفة يعرفون بفلاسفة الاختلاف أو فلاسفة الصوت أمثال: “ميشيل فوكو” و”جاك دريدا” و”جيل دولوز” تتلخص أطروحتهم في الرفض التام لشعار التنوير واعتباره مجرد وهم ليس إلا، يدعو “فوكو” إلى تطوير أنماط جديدة من السلوك والتفكير والرغبة، أنماط تنبني على التعدد والتنوع ويتجلى هذا التصور في تفكيك “فوكو” لميكانيزمات السلطة التي اعتبرها لا نهائية.
نلمس من خلال نصوص هذا التيار الفلسفي نزعة نحو النفي ما بعد الحداثي مثل مصطلحات: التشتيت dispersion، والتفكيك déconstruction، واللااستمرارية discontinuité، والاختلاف différence، والانفصال disjonction.
إننا الآن أمام واقع جديد وأفكار جديدة خلفا لآخر أضحى متجاوزا ومستنفذا، أن تنتهي الحداثة أو لا تنتهي؟
أن تكون ما بعد الحداثة أو لا تكون؟ فإن دينامية الحداثة نشأت واستمرت كحركة دينامية عصفت بكل البنيات والذهنيات العتيقة، وساهمت في إحداث نوع من القطيعة الجذرية مع كل ما هو تقليدي، ومؤدية إلى بلورة تصور جديد للعالم مختلف كليا عن التصور التقليدي، وكما نعلم فإن ما هو حديث يعطي الانطباع بأنه سيصبح قديما، كما أن للحداثة ما قبلها، سيكون لها ما بعدها وهذا ما تبينه البادئة “post” “ما بعد” التي توحي بالنجاوز والبعدية، كما نستشف من مفهوم ما بعد الحداثة تدمير للقوالب الجاهزة، وتقويض كل ما هو نمطي ونمذجي، وتجاوز لمشروع الحداثة الذي انبثق من الأزمة وشكل التشخيص العرضي لجملة من الأزمات.
فمشروع ما بعد الحداثة يطغى عليه خطاب تهويلي جنائزي، مأتمي، فلا يكف عن القول بنهاية التاريخ وموت الإنسان الشيء الذي أدى “بوهرينجر” الفيلسوف الألماني الاستشهاد برأي أستاذه “أدلر” “إن الناس مجرد أدعياء مهولين يهرجون في سرك مريع، فإذا لم يكن بد من لعب السرك فمن المؤسف ألا يكون هذا السرك ملهاة على الأقل” تنضبط ما بعد الحداثة داخل شبكة من التسميات تتسم بالحلكة: “جان فرنسوا ليوتار” اعتبر هذا العصر نهاية لـ”الحكايات الكبرى” Meta-recits، كما تحدث “جان بودريار” عن عصر سيادة المحاكاة والنسغ الباهتة السيمولاكر simulacre، و”ليبوفسكي” عن مجتمع الفراغ و”سمارت” عن عصر الشك.
وبالنسبة للرائز لأسلوب الكتابة الفلسفية الحديثة يجدها تحفها غلالة النسقية عكس فلسفة عصر ما بعد الحداثة التي تتسم بالميل الجارف نحو التشظي والتفتت والندرة Aphorisme والشذرة Fragment لأن هذا الضرب من الكتابة حسب “جيل دولوز” يتضمن صورة جديدة للمفكر وللفكر “كما تعبر عن الإنسان في لا استمراريته وهشاشته، وقد وظف صاحب الجنيالوجيا “فريدريك نيتشه” التشذير بشكل لافت للانتباه في جل أعماله، كما نجد البنيوي الأنتروبولوجي “كلود ليفي ستراوس” والفيلسوف “لودفيغ فيتجنشتاين” صاحب كتابي الرسالة المنطقية الفلسفية وأبحاث فلسفية نبذ فكرة النظام سالكين مسلك اللعبة، وطرحا النسق آخذين بالشذرة. فقد ذهب “فيتجنشتاين” بعيدا حين حاول تطويع اللغة في الحياة اليومية، إلى درجة اعتبار اللغة لعبة كباقي الألعاب أو مدينة أحيانا أخرى، والمتمحص في كتبه يستشف عزوفه عن إعطاء تعريف محدد لمفهوم أو توضيحا مبينا لماهية، يرمي إلى البقاء محايدا حتى لا يسقط خطابه الفلسفي في مدارات البحث عن الماهيات أو جواهر الأشياء.
فإن توظيف أسلوب التشذير يولي الأهمية القصوى للقارئ ويعتبره بمثابة مبدع أول، لا شيء هامشي يستطيع أن يغني النص ويثريه، يتهم المباشر، ينبذ البداهات، ويقوم “بتوليد الاستعارات” كما قال نيتشه، فالنص الشذري نص منفتح ومتفتح يقطنه التنوع والتعدد، نص يفيض لوحده، نص زئبقي لا يمكن الإمساك بتلابيبه بيسر، عكس النص القديم الذي يتسم بالضم والوحدة والتناغم والتطابق والاتصال والتماثل والتشابه، وتملك الحقيقة المطلقة والمعنى الوحيد الأوحد يقول نيتشه: “يجب أن أقول أشياء كثيرة باختصار حتى أسمع أكثر” ولكن بإذن صغيرة كأذن نيتشه لا أذن حمار لأن الشذرة “بؤرة كثافة اقتصادية” أو “فكرة مكثفة” كما يقول الفيلسوف الروماني شيرون Ceron.
عصر ما بعد الحداثة لا يحفل بالنظريات أو الحكايات الكبرى، ويتحفظ من كلية وشمولية الخطاب، ويأبه بالتشظي واللاتحديد، وإلى المعرفة لأننا أصبحنا نرزح تحت وطأة عالم ضخم من التقنية والتكنولوجية الشيء الذي أدى بالعديد من المفاهيم تتوارى وتتهاوى مثل اعتبار الطبيعة مجالا قاصرا، والجسد مرتبطا بالخطأ والخطيئة، ونفس القول يصدق على الخيال والرغبة والعواطف ما هي إلا أشياء مشوشة على العقل، الأمر الذي يبدي على الطابع الإرهابي لهذه النظريات، فانكشفت إرادة القوة التي تهيمن عليها، مما أدى إلى نبذ القول الكلي للعقل ليأخذ بكل ما له علاقة بالتجزيء والتقسيم والتنويع. تبقى ما بعد الحداثة متحققة على مسرح التاريخ أو غير متحققة، هناك أفكارا جديدا فارضة وجودها بقوة، تحت يافطة ما بعد الحداثة، كمفهوم جديد وكمشروع حضاري كوني، وكبديل حقيقي للسابق الذي ترهل كأرجل صنم نيتشه، يتسم خطاب ما بعد الحداثة بلغة مشحونة بالغرائبي والعجائبي، كما تطغى عليه ملامح كوارث الدنيا وفواجعها، يتميز هذا العصر بالأهمية التي صارت تحظى بها المعرفة في الحياة المعاصرة، والتي جعلت منها بدلا من الإنتاج المادي أي الاقتصاد، القوة الرئيسية للتطور والتقدم. حيث أصبح الاقتصاد تابع يتولى من خلاله مهمة إشباع الحاجات الجديدة للثقافة.
الجلي هو أن ما بعد الحداثة جاءت كنفي وتجاوز لأطروحة الحداثة فقامت بتعريتها واستجلاء كل مكامن ضعفها حتى أوصلتها إلى الاحتضار فأعلنت “موت الحداثة” لإعطاء المشروعية لأطروحتها الفلسفية الغربية التي تحاول إصباغها بالصبغة الكونية، لأنها توجد في وضعية متقدمة تسمع لها بتجاوز الآخرين وتفرض عليهم بطريقة أو بأخرى ضرورة العودة إليها، والامتياح من ينابيعها الغزيرة، والاقتباس من إنجازاتها وتجاربها المتعددة والمتنوعة التي لا تنضب.
شتان ما بين عالم يئن تحت وطأة الفاقة والحاجة، لم يحقق بعد المكتسبات البيولوجية، لا زال يكافح من أجل البقاء، وعالم يرفل في النعيم يسمى بعالم الرفاه، يحاول إعادة النظر في الإرهاب الذي مارسه على الطبيعة والبيئة والإنسان، يعي جيدا أنه يعيش مرحلة تاريخية دينامية، تتميز بتحول صاروخي، تتجه بالحضارة الإنسانية إلى الزوال والتلاشي، وبالإنسانية جمعاء إلى الفناء، وخير دليل على ذلك “الذرة” وما شابهها.