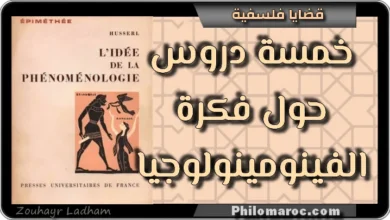الفلسفة والتواصل الرهان والممكن | عز الدين الخطابي
بخصوص الفلسفة والتواصل، تتوزع القضايا المقترحة في هذه الدراسة على فضاءين وهما: فضاء الرهانات وفضاء الممكنات.
فالأول يشمل رهانات ومفارقات العملية التواصلية والتي أثارها باحثون في حقول متعددة [ علوم الإعلام، بسيكولوجيا، سوسيولوجيا الخ…]. أما
الثاني فيتضمن الممكن الكانطي والممكن الهيجيلي في تبليغ الفلسفة وتعليمها، ونود الإشارة هنا إلى أننا سننطلق من فرضية مفادها أن الفلسفة تواصلية، متجنبين الخوض في النقاش الذي أثاره جيل دولوز وفليكس غاتاري عبر المصادر القائلة بأن الفلسفة لا تتأمل ولا تفكر ولا تتواصل.
فكيف تتوزع المساحات والأدوار على هذين الفضاءين؟
1. رهانات ومفارقات التواصل:
رغم أن القاعدة التواصلية تبدو بسيطة وشفافة، حيث تحدد العملية التواصلية كتبليغ لمعلومة (أ) إلى متلقي (ب) بواسطة قناة اتصال (ج)، إلا أن هذه العملية تتضمن رهانات ومفارقات تسمح بإعادة النظر في الشفافية والبساطة المزعومتين.
فالرسائل المبثوتة نادرا ما تكون واضحة وأحادية المعنى، بل إنها على العكس من ذلك تتضمن تعددا دلاليا. كما أن المتلقي لا يكون مجرد مسجل سلبي للمعطيات المرسلة، بل إنه يعمل على انتقاء هذه الأخيرة وغربلتها وتحويلها. وبخصوص قناة الاتصال، فهي بدورها تؤثر في مضمون الرسالة بحسب طبيعة الوسائل المستخدمة [وسائل سمعية بصرية، أسلوب التخاطب المباشر…].
وأخيرا، أثبتت الدراسات في مجال علوم الإعلام أن التواصل لا يتضمن فقط فعل الإخبار، بل يبحث أيضا عن طرق التأثير في الآخر وإيهامه وإغرائه. يتضح إذن بأن التواصل عملية معقدة، من هنا وجب الكشف عن طبيعة هذا التعقيد، وإبراز الرهانات والمفارقات التي تسم هذه العملية.
وقبل ذلك، نشير إلى أن مفهوم المفارقة Paradoxe يؤخذ هنا بمعنى التناقض الناتج عن عمليات استنباطية صحيحة، وذلك انطلاقا من مقدمات وأوليات متماسكة.
ويسمح هذا التحديد بإقصاء كل أشكال المفارقات الزائفة Faux paradoxes القائمة على خطأ برهاني مضمر أو على قول سفسطائي لا يستند على مقدمات متينة. وعادة ما تستعمل لفظة “متناقضات” antinomies كمرادف للفظة مفارقات، خصوصا ضمن الأبحاث ذات الصبغة الصورية، كما هو الأمر في مجال المنطق والرياضيات. [نستحضر هنا متناقضات العقل لدى كانط والمتعلقة بالقضايا الميتافيزيقية الكبرى مثل: الوجود الإلاهي ولا نهائية العالم ومسألة الروح، إلخ..]. وقد مكنت الأبحاث في هذا المجال بتحديد ثلاث أشكال للمفارقات وهي:
- المفارقات المنطقية-الرياضية أو المتناقضات [مثل مفارقات: أخيل والسلحفاة أو السهم الطائر لزينون الإيلي].
- التعريفات المفارقة أو المتناقضات السيمانتيقية، حيث يتخذ الملفوظ دلالة متناقضة [مثل قولي “أنا كذاب”، فدلالة الملفوظ لا يمكن أن تكون حقيقية إلا إذا كانت كاذبة والعكس أيضا. فأنا أقول الحق عندما أكذب!].
- المفارقات التداولية التي تتحدد عبرها التبادلات الإنسانية والسلوكات الواجب اتباعها ضمن هذه التبادلات، وترتبط عادة بما يسمى بالإلزامات المفارقة injonctions paradoxales، كما هو الحال في العبارة التالية: “كن تلقائيا!” فمعلوم أن التلقائية مرتبطة بحرية الفعل وليس بالإلزام.
يتضح إذن بأن المفارقات حاضرة على مختلف المستويات: فكرية ولسانية وسلوكية. ولأن الأمر يتعلق بفعالية الإنسان وبتفاعلاته، فإن فعله التواصلي يظل رهين المفارقات، كما أن رهانه سيتمثل في الحفاظ على تقاليد الحوار والتحاور وقبول الآخر المختلف.
وإذا ما حاولنا تشخيص الوضع التواصلي، فإننا سنتوصل إلى مجموعة من الحقائق منها:
تعدد المعاني التي يحتويها مضمون رسالة ما: إذ أن كل معلومة تتوفر على مضمون ظاهر وآخر خفي. وقد أكدت الأبحاث السيميائية [بيرس، بارث، إيكو…] بأن غموض المعنى يرجع إلى تعدد دلالات العلامات المستخدمة في عملية التواصل.
وفي هذا الإطار، أكدت عمليات تحليل الحوار في مجال الإثنو-لسانيات بأن تبادل العلاقات والرموز، يؤدي إلى العديد من سوء التفاهم وإلى تحويل المعنى المقصود من طرف أحد المخاطبين.
بخصوص قناة الاتصال: هناك تساؤلات تطرحها الأبحاث في مجال التواصل مثل: هل للصورة تأثير أكبر على المتلقي من تأثير المكتوب؟ وهل هذا الأخير أكثر فعالية من الشفوي؟ وهل يساهم التقارب بين المتخاطبين ولقاؤهم المباشر في جعل الرسائل المبثوتة أوضح وأفيد مما هو عليه الحال بالنسبة للرسائل المبثوتة عبر وسائط [ إعلامية أو مؤسساتية]؟
وفي هذا الإطار أيضا، تطرح مسألة استقبال المعلومة من طرف المتلقي الذي لا يمكن اعتباره سلبيا بأية حال، فهو يقوم بفك رموز الرسالة وتحليلها وتأويلها. بحيث تتحكم في ممارسته هاته مجموعة عوامل منها: مرجعيته الثقافية وحمولته المعرفية والمسافة القائمة بين مستواه الثقافي والمستوى المطلوب لفهم المعلومة. وهذا هو المقصود من مفهوم غربلة المعلومات من طرف المتلقي الذي ينعكس انتماؤه الثقافي على مواقفه وردود أفعاله.
وقد دفع هذا الوضع بالباحث أليكس مكييلي A.Mucchielli إلى تحديد مجموعة من الرهانات المطروحة على العملية التواصلية وهي: الرهان الإعلامي، رهان التموقع، رهان التأثير، الرهان العلائقي والرهان المعياري.
فالرهان الأول للتواصل هو نقل المعلومات، ويدعوه جاكوبسون بالوظيفة المرجعية. غير أن التواصل والإخبار قد لا يتلازمان، وعلى سبيل المثال، فإن مهنة التعليم والعمل الصحافي، وإن كان هدفهما هو الإخبار والإعلام، إلا أن بإمكانهما الانسياق وراء رغبة التلاعب بأفكار المتلقي وإغرائه، كما يحدث أحيانا في المجال السياسي.
ويتمثل الرهان الثاني في لعبة التموقعات التي يقوم بها أطراف العملية التواصلية. وإذا ما اعتبرنا مع “إرفين كوفمان” “E.Goffman” بأن العلاقات الإنسانية هي عملية إخراج مسرحي للذات Mise en scène de soi، فإن التواصل سيكون في أساسه بروزا أمام الآخر بمظهر خاص وسيكون الهدف منه تقديم صورة متميزة عن الذات وتبرير مواقفها والدفاع عن ما يميزها كهوية.
ومن هنا يتجلى تأثير الوظائف الاجتماعية والأدوار على عملية التواصل [ إذ أن الوضع المهني مثلا، يختلف عن الوضع داخل الأسرة أو في المقهى أو أمام كاميرا…] ضمن ما يمكن تسميته بلعبة التموقع ورسم الحدود أو “الخطوط الحمراء” التي يجب على الآخر عدم اجتيازها.
أما الرهان الثالث، فيتعلق بالتأثير في الآخر وإقناعه، بل إغرائه وتمويه الحقيقة عليه بهدف جعله مشاركا لنا في الرأي. وتبرز هنا أهمية الحجاج كأداة ضرورية في العملية التواصلية. وقد سبق لحاييم بيرلمان C.Perelman بأن أكد بأن الحجاج يسكن في بيت أغلب أشكال التواصل اللساني، سواء تعلق الأمر بالحوار العادي أو بالمطارحات الفكرية أو بالعروض العلمية. فوراء النقل العادي لمعلومة ما، تكمن الإرادة في المحاجة، أي في إخضاع الآخر لرأينا والتأثير عليه بالتالي.
بخصوص الرهان الرابع، فهو يهدف إلى تنظيم العملية التواصلية، ذلك أن العلاقة بين شخصين نادرا ما تكون تلقائية وبسيطة وهادئة، فهي على العكس من ذلك تتسم في الغالب، بعدم الاستقرار على مستوى السلوك وبالصراع على المستوى العاطفي والفكري. وهنا تبرز ضرورة وضع قواعد لتنظيم عملية التواصل وإخضاعها لآداب المجاملة والحوار [من قبيل: اسمح لي أن أخالفك الرأي، أن أقاطعك، ما رأيك؟..].
والهدف من ذلك، هو ضمان استمرارية التواصل والحفاظ على الرابطة الوجدانية التي تجمع بين المرسل والمتلقي.
ويعتبر الرهان الأخير معياريا، لأنه يخص آفاق العلاقة الإنسانية التي تتلخص في ضرورة بناء مجتمع حواري يوجهه مبدأ قبول الآخر المختلف. فالتواصل، وإن كان ينطلق من استراتيجية تأكيد الذات والتأثير في الآخر، إلا أنه يهدف في العمق إلى بناء ما يسميه هابرماس Habermas بـ”الفضاء العمومي” كفضاء للعلاقات القائمة على الاختلاف والحوار وسيادة روح الديمقراطية والتسامح.
ويمكن تحقيق ذلك، إذا ما نحن شيدنا نموذجا آخر للتواصل، يعوض التعاقد الاجتماعي الكلاسيكي بين الفرد والمجتمع، بتوافق تبلوره المناقشة بين جميع الأفراد بهدف تحقيق “المواطنة الديموقراطية”. ويؤكد هابرماس بأن هذا الأمر سيسمح بخلق علاقات تشاورية تشكل مستوى أرقى من الديموقراطية التمثيلية [البرلمانية]، لأنها ستؤدي إلى تبادلات أوسع يتم فيها إعادة الاعتبار إلى الذات الفاعلة في فضاء المجتمع.
في ضوء هذه المعطيات نتساءل: كيف يتحدد فعل التواصل في درس الفلسفة؟ وما هي رهانات هذا الدرس؟ وكيف يمكن للفلسفة أن تكون فضاءا للحوار وللديمقراطية، وأن تحقق التعايش بين الحرية والضرورة؟
إن الأمر يتعلق هنا تحديدا بالحرية المتمثلة في فعل التفلسف، أي في ممارسة التفكير النقدي التساؤلي وبالضرورة المتمثلة في المؤسسة المدرسية والإلزامات البيداغوجية التي يطرحها تعليم الفلسفة. فما هي تجليات هذه الإشكالية؟ا
2. الفلسفة والتواصل أو مدى قابلية الفلسفة للتعلم:
ترتبط هذه الإشكالية بمسألة تبليغ الفلسفة وإيصالها إلى المتلقي، وهي مسألة وإن كانت راهنة، إلا أنها تحيل على نقاشات فلسفية قديمة، برزت بالخصوص مع أفلاطون ضمن مقولات النضج الفلسفي وسن التفلسف، واستمرت عبر تاريخ الفكر الفلسفي مع كانط، هيجل ونيتشه، وصولا إلى شاتلي، دولوز ودريدا. وقد أثيرت في إطارها علاقة الفلسفة بالمؤسسة [كإنتاج للمعارف وللحقائق ] وأيضا علاقة حرية الفرد في التفكير وفي إصدار الأحكام، بالضرورة البيداغوجية والديداكتيكية.
وسنقتصر على نموذجين أثارا بشكل عميق مثل هذه القضايا، وذلك ضمن استراتيجيتين مختلفتين في تبليغ الفلسفة: تراهن الأولى على تعلم التفلسف وتراهن الثانية على تعليم الفلسفة. إن الأمر يتعلق هنا بالفيلسوفين الألمانيين: كانط وهيجل. فما هي الحجج التي اعتمدها كل فيلسوف لتبرير موقفه؟
1.2 الاستراتيجية الكانطية أو تعلم التفلسف:
لقد انطلق إيمانويل كانط من التمييز بين التفلسف وفكرة الفلسفة. إذ اعتبر بأن فكرة الفلسفة كنسق مكتمل ليست سوى فكرة لعلم ممكن، أما فعل التفلسف فإنه موجود حقيقة، وهو بمثابة تخل عن كل نزعة دوغمائية.
لهذا سيعتبر بأنه لا يمكن تعلم الفلسفة، فما يمكن تعلمه هو التفلسف، لأن الفلسفة هي نسق كل معرفة فلسفية، والفيلسوف هو من يكون قادرا على استخدام ودمج كل المعارف كأدوات لتحديد الغايات الأساسية للعقل الإنساني، وفيلسوف كهذا لم يوجد بعد.
لذا، لا يمكننا أن نتعلم سوى التفلسف كفعل للتفكير يفحص مبادئ الأنسقة الفلسفية ومصادرها، ويعمل على تأييدها أو رفضها وبالتالي يصدر حكما شخصيا قائما على خاصية النقد.
وسيقدم كانط بهذا الصدد مجموعة من الحجج، نعرضها بشكل موجز. هكذا سيعتبر بأن فعل التفكير هو استخدام لملكة العقل، هذا الاستخدام الذي يقوم أساسا على مبدأ الحرية. لذلك فإن التعلم بالنسبة للعقل هو ممارسة الحرية. وسيرفض كانط تبعا لذلك كل ما من شأنه أن يخضع عملية تدريس الفلسفة لشروط مخالفة لتلك التي اختارتها الفلسفة بحرية.
إن تعلم التفكير وممارسته، ليس تعلما لمحتويات أو لأنساق، إنه استعمال نقدي للعقل، وتجاوز لكل الصيغ الدوغمائية التي أسسها العقل نفسه. وهذا الاستعمال النقدي للعقل هو حوار، وباعتباره كذلك، فإنه يحدد الفضاء المؤسساتي للتفلسف كمكان للصراع الفكري وليس أبدا كمكان للحرب أو العنف. ولا يسمح هذا التحديد بوضع تصور دقيق حول ما يجب أن يكون عليه تدريس الفلسفة، فهو يشير فقط إلى ضرورة الاستعمال الحر للعقل النقدي وإلى فهم الممارسة الفلسفية كتفلسف.
وهو ما دفع كانط إلى إقرار الصيغة المشهورة: “لا يمكننا أن نتعلم الفلسفة بل يمكننا أن نتعلم التفلسف”. (أي استعمال قدرة العقل في تطبيق مبادئه العامة على بعض المحاولات التي تظهر أمامه، لكن مع احتفاظ العقل بحقه الدائم في البحث عن هذه المبادئ ذاتها، داخل منابعها والتأكد منها أو رفضها بالتالي). ويمكن للتمعن في هذه الصيغة أن يخرج بملاحظتين أساسيتين:
أولاهما أن كانط يميز بين التفلسف كفعالية عقلية والفلسفة كمعرفة.
وثانيهما أن الفلسفة هي في أساسها شيء آخر غير كونها مادة مدرسية إذ لا يمكننا تعلمها.
ويرجع هذا التحديد إلى تمييز كانط بين المفهوم المدرسي للفلسفة Concept scolastique ومفهومها الكوني: concept cosmique ففي المدرسة يعني التفلسف تمرينا عقليا يتطلب الأناة والصبر، وهو ما يسمى عند كانط كما عند أرسطو بالديالكتيك. أما الفلسفة فإنها مطالبة بتحمل مسؤولية أخرى، فهي لا تحدد ما معنى التفكير فقط، بل تقاس بمثال: إنه مثال الفيلسوف النموذج l’idéal du philosophe type الذي يعتبره كانط مشرع العقل الإنساني.
ويلاحظ جاك دريدا بهذا الصدد، بأن مقولة كانط تسمح بوضع تمييز داخل الفلسفة ذاتها بين “التاريخانية المدرسية” والعقلانية، إذ بإمكان التلاميذ أن يتعلموا ويستظهروا مضامين هي عبارة عن أنساق فلسفية.
وفي هذه الحالة، يمكن لأي كان أن يعتبر تلميذا بغض النظر عن سنه. فبإمكاننا كما يقول كانط، أن نحافظ مدى الحياة على علاقة تاريخية –أي مدرسية- بالفلسفة التي لن تصبح سوى تاريخا لعرض المواقف الفلسفية. وهذا التمييز داخل الفلسفة لا يصدق بالمقابل على الرياضيات التي يمكن معرفتها وتعلمها. فمن بين كل العلوم العقلية، يقول كانط: “يمكن للرياضيات أن تعلم بطريقة عقلية، في حين لا يمكن تعلم الفلسفة [ اللهم إلا إذا كان ذلك بشكل تاريخي ]، أما بخصوص العقل، فلا يمكن أن نتعلم سوى التفلسف”.
يمكننا أن نستنتج –في ضوء ذلك- بأن ماهية الفلسفة تنفي كل إمكانية لتدريسها، أما ماهية التفلسف فتستوجب ذلك، فما يوجد هو فعل التفلسف أما الفلسفة فإنها حاضرة كأثر، وهو ما يفسر إقرار كانط بأن الفلسفة كنسق ليست سوى فكرة لعلم ممكن.
وهنا تواجهنا مجموعة من الأسئلة وهي: كيف تقر بأن الفلسفة غير قابلة للتعلم، من منطلق أنه لا توجد فلسفة نسقية صالحة للجميع أو نؤكد من جانب آخر على أن بإمكانها أن تتواجد داخل فضاء المؤسسة كتفلسف وأنه من الممكن تعلمها باعتبارها كذلك؟
وإذا كانت وظيفة الفلسفة انتقادية أساسا، ألا يعتبر حصرها في مكان ما متناقضا مع جوهرها القائم على التفكير بحرية؟
ألا يستوجب النقد الفلسفي نوعا من الترحال، ومن الاستقلال عن كل مكان مؤسساتي يتضمن في حد ذاته خطر سجن الفكر النقدي ووضعه تحت الإقامة المحروسة؟
يجيبنا كانط بأن الفلسفة هي في الأساس تأمل نقدي، وإذا ما اختزلنا هذه الهوية ضمن مادة مدرسية وجامعية، فإننا سننفي عنها طابعها التأملي وخاصيتها النقدية. بهذا المعنى نستطيع الحديث عن بيداغوجيا التفلسف لدى كانط، ترفض تدريس الفلسفة المذهبية والنسقية، وتعطي الحق للفردانية ولحرية التفكير مع أخذها بعين الاعتبار ضرورة الفكر الكوني الشمولي.
هكذا فإن تدريس الفلسفة يجب أن يركز على تعليم التفكير بهدف تعويد العقل على الممارسة النقدية، كما يجب على الفلسفة أن تنفتح على المؤسسة المدرسية، شريطة ألا تحاصر هذه الأخيرة ممارسة العقل النقدي.
تلك إذن هي استراتيجية كانط المتعلقة بمسألة تعلم التفلسف، فما هو رد هيجل على هذا الموقف؟
2.2 الاستراتيجية الهيجيلية أو تعلم الفلسفة:
بالنسبة لهيجل إن قابلية الفلسفة للتعلم هو ما يجعلها قابلة للتواصل. وما يمكن تعلمه هو محتوى الفلسفة وليس التفلسف كما سبق لكانط أن أقر بذلك. فبتعلمنا لمحتوى الفلسفة، يقول هيجل، لا نتعلم التفلسف فقط، ولكننا نتفلسف فعلا.
كما أن السعي نحو تعلم التفلسف في غياب محتوى الفلسفة، سيؤدي إلى تكوين أذهان فارغة. ولأن فكر المتعلم ناقص ومتعثر ومليئ بالأوهام، فإن تعلم محتوى الفلسفة سيملأ فراغاته، ويجعل الحقيقة تحل محل الفكر الوهمي. “إنني، -يقول هيجل-، أُصاب بفزع عظيم كلما عاينت النقص الكبير في ثقافة ومعارف الطلبة الذين يدرسون بالجامعة، ليس فقط بالنسبة لي، بل كذلك بالنسبة لزملائي، خصوصا عندما أتذكر بأننا معينون لتدريس هؤلاء الأشخاص، وأننا نتحمل مسؤولية تكوينهم، وأن الهدف من هذا التكوين قد لا يتحقق بالرغم من النفقات المخصصة لذلك. غير أن غاية هذا التكوين لا تتعلق فقط بتكوينهم المهني، بل تهدف كذلك إلى تكوينهم الفكري”.
هكذا، فإن الإقرار بتعلم الفلسفة يرجع إلى اعتبار هذه الأخيرة كعلم موضوعي للحقيقة. فالفلسفة كمادة تعليمية، كعلم، ينبغي أن تدرس كباقي العلوم، وينبغي أن تدرس من خلال تاريخ الفلسفة كمحتويات أي كتجليات للحقيقة. وسيضع هيجل خطة لتدريس الفلسفة يشترط فيها أن يكون المدرس متوفرا على خاصتي الوضوح والعمق، وأن يخضع لتطور وتدرج يتناسب مع مستوى المتلقين ومع الحصص الزمنية المخصصة له. وهو ما طرحه في رسالته الموجهة إلى الوزارة الملكية المكلفة بالشؤون الطبية والمدرسية والدينية. إلا أن الملاحظ بالنسبة لهاته الرسالة، هو أن حضور الفلسفة بالثانوي عرضي أكثر منه أساسي. فقد جاء فيها بصريح العبارة: “لست في حاجة إلى أن أوضح بأن العرض الفلسفي يجب أن يقتصر على الجامعة وأن يقصى من التعليم الثانوي”. وسيضيف في موضع آخر بأنه من اللازم إقصاء الميتافيزيقا وتاريخ الفلسفة من المؤسسة الثانوية.
هكذا سيتحدث هيجل عن معارف تحضيرية بالثانوي، وتحديدا في السنة النهائية تسمح بالتحرك داخل مجال الأفكار المجردة والاستئناس بالأفكار الصورية كتحضير مباشر للدراسات الفلسفية بالجامعة.
وتتلخص هذه المعارف في ما يطلق عليه: علم النفس التجريبي الذي يدرس التمثلات الحسية وتخيل الذاكرة بالإضافة إلى ملكات نفسية أخرى.
كما ينحصر هذا التعليم في إعطاء مقدمة في المنطق يكون موضوعها الرئيسي هو الأسس الأولية للمنطق، ويمكن أن يمتد إلى نظرية المفهوم والحكم والقياس بمختلف أشكاله، ومن ثم إلى نظرية التعريف والتقسيم والبرهان. وبنفس الكيفية ستظل بعض المفاهيم المحددة والدقيقة، المتعلقة بطبيعة الإرادة والحرية والقانون والواجب، في موقعها الأصلي بالتعليم الثانوي.
وقد كان هيجل واضحا حينما أكد بأن هذه المعارف تحتاج إلى استعمال الذاكرة، ومن هنا أهمية المحتويات التي يتم تقديمها في هذا الإطار. يقول هيجل: “لن أشعر بالحرج البتة، إذا ما قمت باقتراح شيء من هذا القبيل في هذه المرحلة من التعليم الثانوي. فلامتلاك معرفة ما ومن ضمنها الأكثر سموا، يجب تركيزها أولا في الذاكرة، سواء كان البدء منها أو الانتهاء بها. فإذا كان البدء منها، فسنحصل على مزيد من الحرية وعلى تحفيز للتفكير نفسه. كما يمكننا بالإضافة إلى ذلك التصدي لذلك الذي يرغب حضرة الوزير بحق في تجنبه، ونقصد سقوط التعليم الفلسفي بالثانوي في حشو العبارات الجوفاء، أو تجاوز حدود التعليم المدرسي”.
إن هذا الموقف من مسألة تدريس الفلسفة بالثانوي، سيدفع بالفيلسوف جاك دريدا وضمن قراءة متعمقة لهاته الرسالة إلى إقرار أن فيلسوف يينا يمارس الإقصاء بحق كل إمكانية لممارسة الفلسفة قبل المرحلة الجامعية وإن كان يقترح دروسا تحضيرية للفلسفة بالثانوي بمعدل ساعتين أسبوعيا. هكذا يقول دريدا: “يتم إقصاء الفلسفة بالمعنى الحقيقي، مع قبول تدريس شكلها غير الفلسفي Sa forme improprement philosophique وبطريقة لا فلسفية de façon non philosophique وعبر دروس ذات صبغة معيارية أو إلزامية، مثل دروس الأخلاق، والأخلاق السياسية الخ…”.
هكذا فإن المواد الملقنة في هذه المرحلة [ علم النفس التجريبي، مقدمة المنطق والأخلاق] تبدو معارضة لروح التفلسف القائمة على مبدأ الحرية العقلية والنقد. وهو ما يجعل الطرح الهيجيلي مخالفا في جوهره للطرح الكانطي.
وهنا نتساءل: هل نقر مع كانط بمسألة تعلم التفلسف بما يتضمنه ذلك من مساءلة ونقد؟ أم نساير هيجل القائل بضرورة تعلم محتوى الأفكار وامتلاك المعرفة بالاعتماد على الذاكرة أساسا؟
لنترك السؤال مفتوحا كما يقول هايدجر.
3.2 درس الفلسفة ومسألة الانفتاح على العقلانية والحداثة.
أكد دريدا في نص شهير له بأن قسم الفلسفة في الثانويات هو الفضاء الذي يمكن فيه لنصوص حول الحداثة النظرية والماركسية والتحليل النفسي على الخصوص أن تؤدي إلى ممارسة القراءة والتأويل.
وهذا معناه أن درس الفلسفة هو المجال الذي يمكن فيه الانفتاح على الشأن الإنساني، أي على كل ما له صلة بالفعالية الإنسانية: اجتماعيا وسياسيا وثقافيا وفكريا. ولأن الأمر يتعلق بالإنسان المغربي فإن هذا الدرس يجب أن يراهن على مسألتين أساسيتين وهما: الحداثة والعقلانية.
وقد ارتبط مفهوم الحداثة، كما هو معلوم بمقولات العقل وتقدم العلوم أي بأهمية النشاط العقلاني للإنسان، الذي سيطال مختلف المجالات: تقنية كانت أو إدارية، سياسية أو اقتصادية. لذلك فإن المجتمعات الحديثة قد أسست لمفاهيم مركزية، عرفت انطلاقتها من فكر الأنوار وارتبطت بعد ذلك بفكرة الذاتية والنزعة الإنسانية والتقنية والمشروع الكوني. وتتجلى هذه المفاهيم عبر فكرة المواطنة والديموقراطية والمعرفة النسبية ومفهوم المثقف ومفهوم التاريخ ومفهوم الحق الخ. وهي مفاهيم ملازمة للعقل وللعقلانية. فالحداثة بهذا المعنى هي إقرار للتعدد والاختلاف ورفض للتجانس والتماهي والخضوع، ولذلك فإن مفاهيم الذاتية والفردية والحرية، تشكل العدة التي تتسربل بها المجتمعات الحديثة، حيث تعبر العلاقات الاجتماعية عن حرية الأفراد واستقلالهم الذاتي. وكما يؤكد ألان تورين A.Touraine فإن الفرد مواطن بسبب وجوده الفردي الحر، مثلما أنه حر بسبب المواطنة التي يتمتع بها.
من هذا المنطلق، يمكن اعتبار الفلسفة كمجال لتجلي الفكر الحداثي، لأنها تنبني على الاعتراف بتعدد المواقف والرؤى، وتستند على مبدأ الإنصات والتحاور مع الآخر وعلى المساءلة والنقد، أي أنها تقوم على ما يدعوه كانط بـ”الحرية العقلية” التي لا يمكن للفلسفة أن توجد بدونها.
لذلك، يمكن الإقرار بأن فعل التفكير كاستخدام لملكة العقل، يقوم أساسا على مبدأ الحرية. وشرط التفلسف هو تفعيل الحوار والتخلي عن كل نزعة دوغمائية أو إقصائية، والتأكيد بالتالي على أن الفكر الفلسفي هو وجه من وجوه “الثقافة الديموقراطية”.
ولأن التفلسف هو بمثابة ممارسة نقدية، فهو يستدعي خوض غمار المساءلة والدخول في معترك الأسئلة، عبر تتبع مسارات الفكر الذي ينادينا ويدعونا للقيام بفعل التفكير، فهو إذن دعوة للابتكار والخلق ولخلخلة الثوابت والبديهيات والمطلقات وتفكيكها من الداخل. فعبر عملية التفكيك، تصبح كل القضايا عرضة للمساءلة والنقد والحوار وهذا هو الهدف الأساسي من كل ممارسة فلسفية.
ولأن الفلسفة اختارت هذا المسار منهجا، فإن درسها ملزم بخلق فضاء حواري قائم على الاستفهام والاستشكال، بغية بعث روح النقد والمساءلة لدى متلقي المعرفة الفلسفية. وبطبيعة الحال، فإن ذلك يستوجب توفر فضاء مؤسساتي منبن على الحرية واحترام الآراء المعارضة والمغايرة وإمكانية الإبداع.
إذ لا يمكن الحديث عن حرية الرأي والتعبير داخل القسم، دون ربطها بوضع الحريات بمختلف مؤسسات المجتمع ومن ضمنها المؤسسات التعليمية.
وبذلك سيصبح رهان الفلسفة مجتمعيا وسياسيا وثقافيا، إنه رهان العقلانية والحداثة والحق في الاختلاف، أو بتعبير جاك دريدا: هو رهان “الديموقراطية المنتظرة”