خمسة دروس حول فكرة الفينومينولوجيا – إدموند هوسرل

الدرس الأول
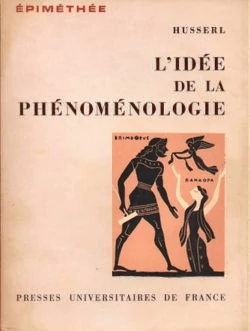
لقد قُمْتُ في الدروس السابقة بالتمييز بين العِلم الطبيعي والعلم الفلسفي. العلم الأول يجد أصله في الموقف الذي يقيمه العقل الطبيعي، والثاني يجد أصله في الموقف الذي يؤسسه العقل الفلسفي. إن العقل الطبيعي لا يهتم بنقد المعرفة. ونحن نتجه-هنا- بالحدس وبالفكر نحو الأشياء التي تعطى لنا في كل مرة. ففي الإدراك البصري، مثلا، يقوم شيء ما أمام أعيننا، وسط الأشياء الأخرى، حي أو غير حي، ذا نفس أو بدون نفس، يعني أنه وسط العالم، في جزء منه يكون تحث نظر أعيننا وفي جزء آخر منه يكون معطى في تسلسل الذكريات فيمتد، بذلك نحو المجهول ونحو اللامحدود
هذا العالم الذي ترتبط به أحكامنا هو الذي نقيم حوله منطوقات أو قضايا، تكون في جزء منها فردية وفي جزء آخر تكون عامة. هي قضايا متعلقة بالأشياء، بالعلاقات القائمة بينها، بتحولاتها، بتبعياتها، وبالقوانين الوظيفية لهذه التحولات. إننا هنا نعبر عن ما تقدمه التجربة المباشرة. وتبعا للمبررات التي تقدمها هذه التجربة نقوم بالاستدلال على ما ليس معطى في هذه لتجربة المباشرة نقوم بعملية تعميمية، ثم نُطَبِّق هذه المعرفة العامة من جديد على حالات خاصة. في الفكر التحليلي تتم عملية استنباط عموميات جديدة من معارف عامة.
غير أن المعرفة لا يتبع أحدها الآخر على طريقة تجاور بسيط، بل إنها تدخل في علاقات منطقية فيما بينها فينحدر بعضها عن بعض، “تتوافق” فيما بينها، يثبت بعضها بعضا، فتزيد، بذلك، في قوتها المنطقية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى تدخل في علاقات تناقض وصراع فيما بينها. وهذا ما يجعل من معرفة ما أن تكون مُلْغاة بفعل معرفة أخرى أكيدة، وتضحى (تلك المعرفة الملغاة) مجرد مزاعم. من الممكن أن يكون أصل التناقضات قائما في دائرة قوانين الشكل الحملي الخالص، تظهر في الحال الذي نكون فيه داخل أشكال من اللبس فنرتكب عددًا من التعارضات، نخطئ ونحن نعد ونحسب. نتجه من تم نحو إقامة التماسك الصوري كي نقضي على أشكال اللُّبس هذه. لكن كيف يمكن الخروج من الصعوبة التالية وهي عندما تقطع التناقضات تسلسل البواعث أو العطاءات التي تؤسس التجربة. هذه التناقضات هي وجود مبررات نابعة من تجربتين تنازع الواحدة الأخرى. لا بد إذن أن نقيم وزنا لتلك المبررات التي تحضر أكثر وتكون صالحة في مختلف إمكانيات التحديد والتفسير. الأكثر ضعفا ينبغي أن يترك الميدان للأكثر قوة …
بهذه الكيفية تتقدم المعرفة الطبيعية. إنها توسع بحثها في الوجود الذي وجوده وحضوره مترادفين، فالأمر هنا لا يتعلق بعملية تنقيب عن هذا الوجود إلا فيما يخص امتداده ومحتواه أي العناصر والعلاقات والقوانين. هكذا تتولد العلوم الطبيعية وتنمو:علوم الطبيعة مثل علوم الطبيعية الفيزيائية والنفسية (علوم الذهن كذلك) من جهة ومن جهة أخرى العلوم الرياضية، علوم الأعداد، المجموعات، العلاقات، الخ.لا يتعلق الأمر في هذه العلوم الأخيرة بتجارب واقعية وإنما بإمكانيات فكرية تحمل الصلاحية في ذاتها، ولكنها لا تطرح مشكلا. في كل خطوة من خطوات المعرفة العلمية الطبيعية تظهر الصعوبات وتنحل. فهذه العلوم تحل الصعوبات إما في ارتباط مع الصورة المنطقية الخالصة وإما في ارتباط مع الأشياء، يعني بفعل دوافع ومبررات قاطنة في الأشياء تظهر منها وتخرج منها كمقتضيات تقدمها إلى الفكر والمعرفة.
سنقوم الآن بمعارضة موقف الفكر الطبيعي والمبررات الطبيعية للفكر بالمبررات الفلسفية. فمع يقظة التفكير حول العلاقة بين الذات والموضوع تم افتتاح عدد من الصعوبات حيث إن المعرفة التي تظهر في الموقف الطبيعي عادية تظهر الآن، دفعة واحدة، كأمر محير. ينبغي، والحالة هذه، أن أكون أكثر تدقيقا فأقول: ما يكون عاديا بالنسبة للفكر الطبيعي هو إمكان المعرفة. إن الفكر الطبيعي، بفعل خصوبة نشاطه وتقدمه في العلوم التي تتجدد باستمرار من اكتشاف إلى آخر، لا يجد أي مبرر يدفعه لإثارة السؤال حول إمكان المعرفة عموما. صحيح أن المعرفة مثل كل شيء آخر في العالم يمكن أن تصبح، بالنسبة للفكر الطبيعي، بمعنى ما، مشكلة. المعرفة نشاط يشكل جزءا من الطبيعة. إنها معيش بعض الكائنات العضوية التي تتمتع بالمعرفة. المعرفة حدث سيكولوجي، وككل حدث سيكولوجي، من الممكن وصفها، وصف أنواعها وأشكال ترابطاتها، يمكن دراسة علاقاتها الأجناسية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى تكون المعرفة، من حيث ماهيتها، هي معرفة الموضوع وذلك بفضل المعنى المُحايِث لها،المعنى الذي به ترتبط بالموضوع.
ينشغل الفكر الطبيعي بهذه الروابط فهو يجعل من العلاقات القبلية للدلالات ومن صلاحية الدلالات وكذلك القوانين القبلية التي تنتمي إلى الموضوع بما هو كذلك، موضوعا للبحث، ولكن في عمومية شكلية. ومن هنا يتولد علم نحوي خاص، كما يظهر في مستوى أعلى منطق خالص. أكثر من ذلك يتولد منطق معياري وتطبيقي كتكنولوجيا للفكر، وخصوصا الفكر العلمي.
إلى هذا الحد نجد أنفسنا في ميدان الفكر الطبيعي. والحال أن الترابط الذي أشرنا إليه لوضع سيكولوجيا المعرفة في تعارض مع المنطق الخالص (وكذلك مع الأنطولوجيات) يعني التعارض بين المَعيش المعرفي، الدلالة، والموضوع، هو مصدر المشاكل الأكثر عمقا والأكثر صعوبة. كي نختزل هذا المشكل في كلمة نقول: إنه إِمْكان المعرفة.
المعرفة في هذا الإشكال هي معيش نفسي. هي ذات عارفة. الموضوعات المعروفة تكون في حالة تعارض معها. كيف يمكن للمعرفة، والحالة هذه، أن تَأْتَمِن على توافقها وتلاؤمها مع الموضوعات التي تعرفها؟ كيف يمكن أن تخرج من ذاتها إلى ما ورائها كي تبلغ بأمان موضوعاتها؟ هكذا يتوقف حضور موضوعات المعرفة في المعرفة من أن يكون عاديا كما هو الحال في الفكر الطبيعي ليصبح لغزا.
في الإدراك يبدو الشيء المدرك كشيء معطى مباشرة. هذا هو ذلك الشيء. إنه هناك أمام عيني اللتين تدركانه إنني أراه وأمسك به. أما الإدراك فإنه ليس سوى معيش ذات هي ذاتي التي تدرك. وبالمثل فإن الذكرى والانتظار وجميع أفعال الفكر التي تنبني عليها، والتي بفعلها يتكون موقف غير مباشر لكائن واقعي، وكذلك إثبات كل نوع من أنواع الحقيقة عن الوجود، كل ذلك هو معيشات ذاتية. من أين لي أن أعلم، أنا الذي يعرف، بأن أفعال التّعرف الموجودة هذه ليست وحدها معيشاتي وإنما كذلك ما أعرفه؟.من أين لي أن أعلم بأن هناك أي شيء يمكنه أن يعارض المعرفة من حيث يكون هو موضوعها؟ هل ينبغي علي أن أقول بأن الظواهر هي وحدها التي تكون معطاة، حقيقة، للذات العارفة، أم أن هذه الأخيرة لا تصل أبدا إلى ما وراء تسلسل معيشاتها وبالتالي فإن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يكون هو أنني موجود؟ اللاأنا هو بكل بساطة ظاهرة تذوب في العلاقات الظواهرية. هل يجب علي إذن أن أتبنى وجهة نظر الأناوحدية solipsismeوأعتبرها منظورا صلبا؟ هل يجب أن أستنبط مع هيوم الموضوعية المتعالية للوهم والتي تترك نفسها تفسر من طرف علم النفس دون أن تكون مبررة بشكل عقلاني؟ لكن هذا أيضا منظور صلب. ألا تجعل سيكولوجيا هيوم، كأية سيكولوجيا أخرى، دائرة المحايثة متعالية؟
ألا تشتغل تحث عناوين من طراز: عادة، طبيعة إنسانية، عضو الإحساس، الإثارة، الخ، مع كيانات أخرى متعالية عندما تسعى إلى استخلاص الوهم بحيث تتعالى المعرفة عن الانطباعات والأفكار الراهنة؟
لكن لأي شيء سيكون المنطق مفيدا ما دام هو نفسه يوضع موضع تساؤل ويصبح إشكاليا؟ في الواقع أن صلاحية القوانين المنطقية بالنسبة لما هو واقعي، هي في نظر الفكر الطبيعي في منأى عن الشك. هذه الصلاحية تصبح الآن إشكالية بل وريبية. إن اعتبارات بيولوجية تفرض نفسها على الذهن. إننا نتذكر هنا النظرية الحديثة عن التطور والتي بحسبها حصل تتطور الإنسان ضمن الصراع من أجل الحياة وبفضل الانتقاء الطبيعي.لقد تتطور الإنسان ومعه عقله مع جميع الأشكال التي تخصه ومن بينها الأشكال المنطقية. ألا يمكن القول بأن الأشكال والقوانين المنطقية تعبر عن الصفة الإمكانية أو الاحتمالية للنوع الإنساني بحيث يكون من الجائز أن يصير آخر أو يصبح آخر عبر التطور المستقبلي؟ المعرفة هي إذن فقط إنسانية، بمعنى أنها مرتبطة بالأشكال العقلية للإنسان ومن تم عاجزة عن بلوغ طبيعة الأشياء، عن بلوغ الأشياء في ذواتها.
لكن إذا ما تم التضحية بالقوانين المنطقية سوف ينبثق من جديد لا معنى ما، إذ يمكن التساؤل حول ما إذا كان من الممكن أن يكون لهذه المعارف، التي سيتم بها فحص تصور مثل هذا والإمكانات التي يتبصرها هذا التصور، معنى داخل نِسْبَوِيَّة مثل هذه؟.في الحقيقة يوجد هذا الإمكان أو ذاك. لكن ألا نفترض ضمنيا الصلاحية المطلقة لمبدأ التناقض الذي بحسبه يتم إقصاء تناقض حقيقة ما؟
هذه الأمثلة كافية، إذ أن إمكان المعرفة يصبح في كل مكان لغزا محيرا.إننا عندما نلج العلوم الطبيعية كي نعيش داخلها، نلتقي بكل شيء قد بلغ مرحلة الدقة والوضوح والمفهومية conceptualité يحصل لدينا اليقين بأننا هنا نتملك حقيقة موضوعية مبرهن عليها بفعل مناهج أكيدة، مناهج تتوصل، بصورة واقعية إلى الموضوعية. وبمجرد ما ننتقل إلى التأمل حتى نجد أنفسنا في لُبس، في فوضى وتضليل. نسبح هنا في تشويش حاصل عن تعارضات ظاهرة بل وتناقضات. فنحن هنا دوما في خطر السقوط في الريبية. وبالأحرى في مختلف أشكال الريبية التي، سِمتها للأسف، هي العبث دائما.
مسرح أشكال اللبس هذه والنظريات المتناقضة وكذا الخصومات المرتبطة بها والتي لا تنتهي إنما هو(مسرح) نظرية المعرفة وكذلك الميتافيزيقا المرتبطة بها والتي هي تاريخيا وكأنها من طرف طبيعة الأشياء. إن مهمة نظرية المعرفة هي أولا وقبل كل شيء مهمة نقدية، فعليها أن تفضح أشكال اللبس والغموض التي سقط فيها التفكير الطبيعي حتما حول العلاقة بين المعرفة، المعنى المعرفي وموضوع المعرفة. يجب عليها بالتالي أن تفند النظريات الريبية بإظهار عبثيتها فيما يخص ماهية المعرفة سواء كان ذلك بشكل ظاهر أو بشكل خفي.
من جهة أخرى، فإن لنظرية المعرفة أيضا، من خلال دراسة ماهية المعرفة، مهمة إيجابية تتجلى في تبني حل للمشاكل التي تقوم في الترابط بين المعرفة، المعنى المعرفي وموضوع المعرفة. من بين هذه المشاكل مشكل تبيان المعنى (الجوهري) لموضوع المعرفة وما يعود إلى الموضوع عموما: إنه المعنى المرسوم للموضوع قبليا (يعني بالتطابق مع الماهية ) بفعل الترابط بين المعرفة وموضوع المعرفة.إن هذا يشمل طبعا جميع الأوجه التي تفرضها ماهية المعرفة والموضوعات عموما( الأشكال الأنطلوجية والقضوية والميتافيزيقية كذلك)
بفعل هذه المهام تصبح نظرية المعرفة مؤهلة لنقد المعرفة أو بشكل أوضح مؤهلة لنقد المعرفة الطبيعية في العلوم الطبيعية كلها.إنها تضعنا في حالة من التأويل المضبوط والمحدد لنتائج العلوم الطبيعية المتعلقة بالوجود .فالغموض الغنوصيولوجي gnoséologique الذي يضعنا فيه التفكير الطبيعي(السابق على نظرية المعرفة) حول إمكان المعرفة (حول صلاحية ممكنة للمعرفة) ليس من نتائجه حصول تصورات مغلوطة تتعلق بماهية المعرفة، وإنما أيضا تأويلات خاطئة، بشكل جوهري، للوجود المعروف في العلوم الطبيعية،-لأنها متناقضة في ذاتها. بحسب التأويل الذي (يقول) أن مثل هذه التأملات تقود إلى ضرورة تأويل علم طبيعي، ثارة في معنى مادي، ثارة في معنى روحي ثارة في معنى ثنائي سيكوأحادي وضعي، وفي معاني أخرى كثيرة. مع التفكير الغنوصيولوجي فقط يتم التمييز بين العلم الطبيعي والفلسفة. وفقط بفضله تظهر العلوم الطبيعية بأنها ليست علوما نهائية عن الوجود. ينبغي أن يقوم هناك علم عن الوجود يكون مطلقا. هذا العلم الذي نطلق عليه اسم ميتافيزيقا يتولد عن (نقد) للمعرفة الطبيعية للعلوم الجزئية، نقد يستند إلى ما هو مكتسب في النقد العام للمعرفة، لماهية المعرفة، لموضوع المعرفة، في أوجهه الأساسية المختلفة، يستند إلى الذكاء الحاصل من مختلف الترابطات الأساسية بين المعرفة وموضوع المعرفة.
إذا ما أغضضنا الطرف عن التطبيقات الميتافيزيقية لنقد المعرفة كي نتشبث بكل بساطة بمهمته الخاصة التي هي الإبانة عن ماهية المعرفة وموضوع المعرفة، فإن هذا النقد سيكون هو فينومينولوجيا المعرفة وفينومينولوجيا موضوع المعرفة ويشكل من تم الجزء الأول والأساسي للفينومينولوجيا على العموم.
فينومينولوجيا: هذا تعيين لعلم، لمجموعة من الشُّعب العلمية. لكن، فينومينولوجيا، (مصطلح) يعين أولا وقبل كل شيء منهجا وموقفا فكريا: موقف فكر فلسفي بشكل خاص ومنهج فلسفي بشكل خاص.
إن المستوى الذي تزعم فيه الفلسفة المعاصرة بأن تصير علما قد صار مكانا مشتركا حيث إن جميع العلوم وكذلك الفلسفة تشترك في منهج للمعرفة. وهذا الاقتناع يستجيب بشكل مطلق للأشكال التراثية الكبرى لفلسفة القرن السابع عشر والتي اعتقدت فعليا بأن سلام الفلسفة هو في أن تتخذ لنفسها العلوم الدقيقة نموذجا منهجيا، وقبل كل شيء الرياضيات والعلوم الرياضية للطبيعة. على أساس هذا التمثل والاستيعاب للعلوم الذي تقوم به الفلسفة فيما يتعلق بالمنهج يقوم كذلك تمثلها للموضوع، وينبغي علينا أن نعتبر بأن الرأي المهيمن اليوم هو أن الفلسفة، وبشكل أدق، المذهب الأخير حول الوجود والعلم، يمكنها أن ترتبط، ليس فقط بكل العلوم، وإنما يمكنها أيضا، أن تتأسس على نتائجها
وبنفس الكيفية التي تتأسس فيه العلوم الواحدة على الأخرى، فإن نتائج إحداها يمكن أن تصلح كأوليات للأخرى. أستحضر هنا المحاولات المشهورة التي أسست نظرية المعرفة على سيكولوجيا المعرفة وعلى البيولوجيا. وفي يومنا هذا تعددت ردود الأفعال ضد هذه الأحكام المميتة إنها فعلا أحكام قاتلة. يمكن لعلم، في دائرة البحث الطبيعي، أن يبني صرحه، بدون صعوبات، على علم آخر، كما يمكن لعلم واحد أن يصلح كنموذج منهجي لآخر، لكن في بعض الحدود المحاطة بطبيعة ميادين بحث معينة. غير أن الفلسفة تتموضع في بُعد جديد كلية. فهي تحتاج إلى نقط انطلاق جديدة كلية، وإلى منهج جديد كلية، يميزها، من حيث المبدأ، عن كل علم “طبيعي”. هذا يعني بأن الإجراءات المنهجية للفلسفة كوحدة جديدة، من حيث المبدأ، تتعارض مع الإجراءات المنطقية التي تعطي الوحدة للعلوم الطبيعية. وهذا يعني كذلك أنه في دائرة نقد المعرفة والشُّعَب النقدية على العموم، ينبغي للفلسفة (الخالصة) أن تغض الطرف عن كل ما أنجزه الفكر في العلوم الطبيعية وفي الحكمة والعرفان وأن لا تقيم له أي وزن.
سوف نقوم بتبرير هذا المذهب بشكل أكثر توسعا في التفاصيل اللاحقة، هذا المذهب يصبح واضحا دفعة واحدة على ضوء الاعتبار التالي: في الوسط الريبي الذي صنعه بالضرورة التفكير التأملي حول نقد المعرفة (أقصد بذلك ذلك التفكير الأولي الذي يوجد قبل النقد العلمي للمعرفة ويحدث تبعا لطريقة التفكير الطبيعي)، يتوقف كل علم طبيعي وكل منهج علمي طبيعي من أن يكونا معدين لنفع ما فالصلاحية الموضوعية للمعرفة على العموم قد أصبحت، فيما يخص معناها وإمكانها لغزا، وبالتالي هي شَكِّيَّة. المعرفة الدقيقة تصبح من هنا لغزا تماما مثل المعرفة الغير دقيقة، والمعرفة العلمية تكون تماما مثل المعرفة الما-قبل علمية. ما يصبح إشكاليا إنما هو إمكان المعرفة، وبالضبط إمكان أن تبلغ المعرفة الموضوع كما هو عليه في نفسه. هذا أمر يتضمن كَوْن ما تدعيه المعرفة من صلاحية ومشروعية (أي) التمييز بين معرفة مشروعة وأخرى مزعومة يصبح موضع تساؤل. كما أن معنى الموضوع، سواء كان معروفا أم غير معروف، ولكن، من حيث هو موضوع يمكن أن يكون موضوع معرفة ممكنة، أي يكون من حيث المبدأ، قابلا للمعرفة حتى ولو لم يكن قط معروفا ولن يعرف قط بالفعل يكون من حيث المبدأ قابلا للإدراك، للتمثل، للتحديد، بواسطة محمولات ضمن تفكير حملي ممكن، الخ.
غير أننا لا نرى، والحالة هذه، كيف يمكن أن يساعدنا اللجوء إلى افتراضات مسبقة، مستعارة من المعرفة الطبيعية، على تذويب الشكوك التي تثار في مجال نقد المعرفة والإجابة عن مشاكلها؟ فإذا كان معنى وقيمة المعرفة الطبيعية عموما وكذلك مختلف عملياتها الميتودولوجية وبراهينها الدقيقة تصبح إشكالية، فإن هذا سيتعلق، أيضا، بكل قضية مستعارة من دائرة المعرفة الطبيعية التي نريد أن نتخذها كنقطة انطلاق. كذلك، فإن كل منهج يعتبر نفسه دقيقا في برهنته، العلم الطبيعي الأكثر صرامة والعلم الرياضي للطبيعة، ليس له هنا أدنى تفوق بالقياس إلى المعرفة الواقعية لتجربة مشتركة ما، أو التي نفترض أنها واقعية. من الواضح، إذن، أنه سوف لا يكون هناك سؤال يزعم بأنه يتوجب على الفلسفة (التي تبدأ بالفعل مع نقد المعرفة، وما تقوم به يحصل طبعا داخل هذا النقد) أن تسير على هُدى العلوم الدقيقة فيما يخص المنهج (بل وحتى فيما يخص الموضوع)، أن تتخذ منهجها كنموذج، وأنه ليس عليها إلا أن تتابع وتتمم العمل المنجز في العلوم الدقيقة، وذلك تبعا للمنهج الذي هو هو في جميع العلوم. إن الفلسفة، وأنا أكرر هذا، تقوم في بعد جديد إزاء كل معرفة طبيعية. يستجيب لهذا البعد الجديد تلك الاستعارة التي تقيم علاقات مع البعد القديم.هذا البعد الجديد للغاية هو في تعارض مع المنهج “الطبيعي”.إن من ينكر هذا لن يفهم أي شيء عن نقد المعرفة وبالتالي لن يفهم أي شيء عن ماذا تعنيه الفلسفة وما تستحقه وما تقدمه إزاء كل معرفة وعلم طبيعيين لن يفهم خاصيتها ومبررها
الدرس الثاني
إن مجموع العالم الطبيعي والفيزيائي والنفسي وكذلك أَنَايَ (الإنساني) الخاص وكل العلوم التي تتعلق بهذه المواضيع هو الذي يتسم، في بداية نقد المعرفة، بطابع إشكالي. فوجود هذا العالم وعلومه وَأَنَايَ وصلاحيته (كل ذلك) يبقى معلقا.
كيف يمكن لسؤال نقد المعرفة الآن أن يقوم؟ إن هذا (النقد)، من حيث هو مجهود المعرفة في فهم ذاتها علميا، يسعى وهو يشتغل بمعرفة علمية، إلى أن يقيم ما تكون عليه المعرفة في ماهيتها، ومن هنا يقوم بِمَوْضَعَة هذا الذي يغطيه معنى العلاقة بالموضوع الذي ينسب إليه، وكذلك معنى الصلاحية الموضوعية أو معنى خاصية بلوغ الموضوع، الذي يجب أن يكون موضوعه هو، عندما يتوجب عليه أن يكون معرفة بالمعنى الأصيل. إن الذي ينبغي أن يمارسه نقد المعرفة لا يمكن أن يعني إلا هذا، ليس فقط بأن يبدأ بالوضع موضع تساؤل، وإنما كذلك بأن يستمر دوما في أن يضع كل معرفة موضع تساؤل (إذن كذلك معرفته) وبأن لا يترك أي معطى بلا تقييم (إذن كذاك الذي يقيمه هو نفسه). إذا توجب عليه أن لا يفترض مسبقا أي شيء كمعطى من قبل، يعني أنه يجب عليه أن يبدأ بمعرفة ما، لا يستعيرها- طبعا- بدون فحص، وإنما من تلك التي يقدمها-على العكس من ذلك -عن نفسه. فهو يطرحها كمعرفة أولى.
لا ينبغي لهذه المعرفة الأولى أن تحمل أي لُبس وظن يمنحان للمعارف صفة شيء ملغز، وإشكالي وهو ما وضعناه، أخيرا، في مثل هذا الارتباك الذي دفعنا إلى القول بأن المعرفة عموما هي مشكلة، هي شيء غير مفهوم، شيء يكون في حاجة إلى توضيح، والذي في ادعاءه، شكي. لكي نعبر عن هذا بشكل ترابطي نقول: إذا كان ممنوعا علينا أن لا نقبل أي موجود كمعطى من قبل، نظرا للغموض الذي نوجد فيه داخل نقد المعرفة – بمعنى أننا لا نفهم ما الذي سيكونه معنى وجود يكون في ذاته، ومع ذلك يكون معروفا داخل المعرفة– فإنه ينبغي أن نكون قادرين، مع ذلك، على تبيان موجود نكون ملزمين على أن نعترف به كمعطى مطلق وبلا ريب، في المستوى الذي يكون فيه بالضبط معطى بكيفية يحمل معه فيها وضوحا تاما، انطلاقا منه كل سؤال يجب أن يجد جوابه المباشر.
والآن لنذكر بطريقة الشك الديكارتية. فبالنظر إلى الإمكانات المتعددة للخطأ والوهم، يكون من الممكن أن أسقط في قنوط ريبي يجعلني أنتهي إلى القول بأن لا شيء هو يقيني بالنسبة لي، كل شيء هو مشكوك فيه. لكن، في الحال وعلى الفور، يكون من البديهي، مع ذلك، أن لا يكون كل شيء مشكوكا فيه، لأنه في الوقت الذي فيه أحكم على أن كل شيء هو مشكوك فيه بالنسبة لي فإن ما لا ريب فيه، عندما أحكم هكذا، هو أنني أسعى للحفاظ على شك كوني. هذا من العبث. ومما لا ريب فيه، في كل حالة من حالات الشك المحدد، أنني أشك بكيفية محددة. وأن هذا يسري أيضا على كل cogitatio (موضوع الفكر) إنه في أية كيفية أدرك بها وأتمثل وأحكم وأستدل، ومهما كان يقين أو لا يقين هذه الأفعال، وجود أو لا-وجود موضوعاتها، يكون من الواضح ومن الأكيد، وأنا أوجه نظرتي على فعل الإدراك أنني أدرك هذا أو ذاك، وبتوجيه هذه النظرة على الحكم بأنني أحكم على هذا أو ذاك، الخ.
لقد لجأ ديكارت إلى هذا الاعتبار من أجل أهداف أخرى، نستطيع، والحالة هذه، أن نستخدم هنا هذا الاعتبار مُعَدِّلين إياه بصورة ملائمة.
عندما نسعى إلى معرفة ماهية المعرفة، فإن المعرفة هي التي تكون-مهما كان الشك المتعلق بصلاحيتها وبهذه الصلاحية نفسها، بصورة ظاهرة -العنوان الذي يعين الشكل المتعدد لدائرة الوجود الذي يكون قابلا بأن يُعْطَى لنا بشكل مطلق. لأن أوجهه figuresالفردية يمكن أن تكون في كل لحظة معطاة لنا بشكل مطلق فعلا. لأن أوجه الفكر هي معطاة لي شريطة أن أتأملها وأن أتلقاها وأضعها بشكل خالص كما أراها. أستطيع أن أتكلم بكيفية ملتبسة عن المعرفة، الإدراك، التمثل، التجربة، الحكم، الاستدلال، الخ. في هذه الحالة، طبعا، عندما أتأمل، فإن الشيء الوحيد الذي يكون معطى لي إنما هو ظاهرة الالتباس هذا، لكنه معطى لي بكيفية مطلقة “التكلم عن المعرفة أو استهداف التجربة، الحكم، الاستدلال، الخ”.إن ظاهرة الالتباس هذه هي من بين تلك التي نصادفها تحت عنوان المعرفة بالمعنى الواسع جدا. لكنني أستطيع كذلك إنجاز إدراك الآن وأن أوجه نظرتي نحوه، أستطيع فضلا عن ذلك بأن أتمثل إدراكا في الخيال أو في الذكرى وأن أوجه نظرتي نحوه باعتباره معطى هكذا في الخيال. لم أعد أمتلك إذن خطابا فارغا أو منظورا تمثلا ملتبسا عن الإدراك، إنما الإدراك يجد نفسه تقريبا أمام عيني، كمعطى راهني أو كمعطى للخيال. وإن هذا يصدق على كل معيش ذهنيvecu intellectuel ، على كل وجه من أوجه الفكر، وعلى المعرفة.
لقد وضعت على الفور، هنا جنبا إلى جنب، رؤية الإدراك التَّأملي والخيال التأملي. وتبعا للطريقة الديكارتية، فإنه ينبغي، أولا، توضيح الإدراك: ذاك الذي يتطابق، في مستوى ما، مع ما يسمى في النظرية التقليدية للمعرفة، الإدراك الباطني (وهو مصطلح ملتبس تماما)
كل معيش ذهني وكل معيش على العموم، في اللحظة التي يتحقق فيها، يمكن أن يصبح موضوعا لرؤية ولضبط محض، وأنه في هذه الرؤية يكون معطى مطلق. إنه معطى كموجود باعتباره “هذا الذي [أمامي]” والذي يكون من باب اللا-معنى وضع وجوده موضع شك. يمكنني أن أتساءل حول أي نوع من الوجود يتعلق به الأمر هنا، وما هي علاقة هذا النمط من الوجود بأنماط الوجود الأخرى. أستطيع من جهة أخرى أن أتساءل عما يعنيه هنا العطاء والحضور، وأستطيع- دافعا بالتأمل بعيدا-أن أقود تحت رؤية ما، هذه الرؤية نفسها والتي يتشكل فيها هذا العطاء أو هذا النمط من الوجود. لكنني في كل هذا أتحرك باستمرار فوق ميدان مطلق، يعني أن هذا الإدراك يكون، ويبقى، ما دام مستمرا، مطلقا، “هذا الذي [أمامي ]”، يظل شيئا ما يكون في نفسه ما هو عليه، شيئا ما أستطيع أن أقيس عليه كما لو أن الأمر يتعلق بمقياس نهائي. ما يمكن أن يعنيه أن تكون، وأن تكون معطى، وما الذي ينبغي أن يعنيه، هنا على الأقل طبعا، بالنسبة لنمط الوجود والحضور الذي يعتبر فيه “هذا الذي [أمامي]” مثالا. وهذا (أمر) يصدق على جميع الأوجه الخصوصية للفكر، حيثما تكون معطاة. (لكن يمكن أن تكون كلها معطيات في الخيال، يمكن أن تكون “شبه” حاضرة أمام أعيننا بدون أن تكون كحضورات حالية، كإدراكات، كأحكام، الخ، تحققت حاليا. فحتى إذا كانت بمعنى ما معطيات فإنها توجد هنا بكيفية حدسية، لا نتكلم عنها فقط في شكل تعيين ملتبس، في إطار منظور فارغ: إننا نراها ونستطيع، ونحن نراها، أن نمسك بماهيتها، تكوينها، بصفتها المحايثة وأن نعدل خطابنا بكيفية ملائمة تماما مع الوضوح التام الذي يقدم نفسه للنظر. إن هذا، والحالة هذه، سيتطلب على الفور بأن يكتمل عن طريق مناقشة تتعلق بمفهوم الماهية ومعرفة الماهية.)
في انتظار ذلك، نُقِرّ بأنه من الممكن تعيين دائرة حضور مطلق، هو الدائرة التي نحن في حاجة إليها بالضبط، إذا كان ينبغي لهدفنا، هدف إقامة نظرية للمعرفة، أن يكون ممكنا. وبالفعل، فإن الغموض الذي يلف المعرفة، فيما يتعلق بمعناها أو بماهيتها، يستدعي علما بالمعرفة، علما لا يبتغي شيئا آخر سوى أن يقود المعرفة نحو وضوح فعلي. لا يسعى علم المعرفة هذا إلى تفسير المعرفة باعتبارها حدثا سيكولوجيا، ولا إلى أن يدرس شروط نظام الطبيعة التي تظهر فيها المعارف وتتوارى وأن يدرس قوانين الطبيعة التي ترتبط بها في صيرورتها وتحولاتها. فدراسة هذه الأمور هي من مهمة علم طبيعي، علم الطبيعة الذي يتعلق بالظواهر النفسية، بالمعيشات النفسية التي يحياها الأفراد. وعلى العكس من ذلك فإن ما يسعى إليه نقد المعرفة إنما هو إبراز وشرح وتوضيح ماهية المعرفة وكذلك مطالبته بالصلاحية التي تشكل جزءا من ماهيتها (إن توضيحهما، إنما يرجع إلى حضور-مباشر-بشخصه.)
تلخيص وتكملة. تتيقن المعرفة الطبيعية من صلاحيتها وهي تتقدم باستمرار وبنجاح في مختلف العلوم، وليس لديها أي مبرر للعثور على مشكل ما في إمكان المعرفة ولا في معنى الموضوع المعروف. لكن حالما ينصرف التفكير نحو الترابط القائم بين المعرفة والموضوع، (وعند الاقتضاء كذلك نحو المحتوى المثالي والدال للمعرفة في علاقتها بالفعل المعرفي، من جهة، ونحو موضوع المعرفة من جهة أخرى) فإن صعوبات وتعارضات تطفو على السطح، ونظريات تتناقض تبدو مؤسسة، والتي تدفع إلى الاعتراف بأن إمكان المعرفة هو على العموم (فيما يخص صلاحيتها) يعتبر لغزا.
إن علما جديدا يولد هنا، [هو] نقد المعرفة الذي يريد أن يبدد هذه العقبات وأن يوضح لنا ماهية المعرفة. نجاح هذا العلم يتعلق، على ما يبدو، بإمكان ميتافيزيقا، (إمكان) علم بالوجود بالمعنى المطلق والنهائي. لكن كيف يمكن لعلم المعرفة عموما، مثل، هذا أن يقوم؟ إن ما يضعه علم ما موضع سؤال لا يمكن أن يستخدمه كأساس معطى من قبل. والحال أن كل معرفة هي التي توضع (هنا) موضع سؤال، لأن إمكان المعرفة عموما هو الذي يعلن عنه نقد المعرفة (فيما يتعلق بصلاحيتها) بأنه إشكالي.فعندما يبدأ [ هذا النقد ] لا معرفة تستحق أن تعتبر معطاة. إنه، إذن، لا يستطيع أن يستعير أي شيء من أية دائرة من دوائر المعرفة الما-قبل علمية، فكل معرفة تحمل (معها) مؤشر إشكالية.
بدون معرفة معطاة كبداية لا تكون هناك أية معرفة لاحقة. هكذا فإن نقد المعرفة لا يتمكن من أن يبدأ. فلا يمكن أن يكون هناك علم مثل هذا.
والحال أنني كنت أريد أن أقول، بأنه في هذا يوجد ما هو صائب، وهو أنه لا معرفة تستحق أن تعتبر في البداية كمعطى بدون فحص. لكن إن كان ممنوعا على نقد المعرفة أن يستقبل دفعة واحدة معرفة ما مستعارة من مكان ما، فإنه يستطيع أن يبدأ بصنع معرفة، وبالطبع ليست معرفة لم يبرهن عليها، ولم يستنبطها منطقيا، الأمر الذي يتطلب معارف مباشرة يجب أن تكون معطيات من قبل، وإنما معرفة يضعها في الضوء بكيفية مباشرة والتي تكون واضحة بشكل مطلق ولا ريب فيه، بحيث تستبعد كل شك بصدد إمكانها، ولا تحمل على القطع أي شيء من اللغز الذي ينعش جميع العقبات الريبية. وإنه، هاهنا، استدعيت طريقة الشك الديكارتية ودائرة المعطيات المطلقة، أو دائرة المعرفة المطلقة التي تندرج ضمن عنوان بداهة الفكرcogitatio.
يتعلق الأمر الآن بأن نبين عن قرب أن محايثة هذه المعرفة تجعلها [تجعل هذه المعرفة ] صافية لتصلح كنقطة الانطلاق الأولى لنظرية المعرفة، وأنه كذلك بفضل هذه المحايثة تكون هذه المعرفة متحررة من سمة اللغز الذي هو مصدر جميع العقبات الريبية، وأخيرا بأن تكون المحايثة، بصفة عامة، هي الخاصية الضرورية لكل معرفة عرفانية، وأنه من باب اللا-معنى استعارة أي شيء من دائرة التعالي، ليس فقط عند البداية وإنما بكيفية عامة، وبعبارة أخرى بتأسيس نظرية المعرفة على السيكولوجيا أوعلى أي علم طبيعي كيفما كان.
ومن باب التكملة أضيف كذلك ما يلي: إن الحِجَاج المقبول جدا هو كيف لنظرية المعرفة-على اعتبار أنها تضع كل معرفة على العموم موضع سؤال-أن تبدأ إذ أن كل معرفة تصلح كبداية هي في نفس الوقت باعتبارها معرفة توضع موضع سؤال، وإن كانت كل معرفة بالنسبة لنظرية المعرفة لغزا فإن أول معرفة، تلك التي تبدأ بها هي نفسها تكون هي كذلك لغزا، أقول بأن هذا الحِجاج المقبول جدا هو طبعا حجاج مغلوط. إن الوهم آتٍ من العمومية الفضفاضة للغة. القول بأن المعرفة هي على العموم “توضع موضع سؤال” لا يعني طبعا بأننا ننكر على العموم وجود أية معرفة (الشيء الذي يقود إلى عبث) وإنما أن المعرفة تحتوى على مشكلة وهي مشكلة فهم كيف يمكن للعمل المنسوب إليها،[أي] بلوغ موضوعها أن يكون ممكنا. وأنني أشك، ربما، حتى فيما إذا كان ممكنا. والحال أنه حتى ولو أنني أشك هكذا فإن خطوة أولى تشتمل تقريبا على أن نرفع على الفور هذا الشك، من جَرّاء أن بعض المعارف يمكن أن تتضح فتجعل شكًّا مثل هذا بلا موضوع. من جهة أخرى عندما ابتدأ بالقول بأنني لا أفهم المعرفة تماما فإن هذا لا أفهم يغطي من دون شك في عموميته اللامحددة، كل معرفة. لكن لم يقل بأن كل معرفة سألتقي بها في المستقبل يجب أن تبقى بالنسبة لي على الدوام غير مفهومة. قد يحدث أن يكون لغز كبير مرتبطا بصنف من المعارف الذي يفرض نفسه أولا في كل مكان، وأنه بالسقوط في مأزق عام سأقول إذن: المعرفة هي على العموم لغز، في الوقت الذي تظهر فيه وأنه في معارف أخرى يكون هذا اللغز غائبا. وكما سنرى ذلك فإن هذا صحيح.
لقد قلت بأن المعارف التي يجب أن يبدأ بها نقد المعرفة لا ينبغي أن تتضمن أي شيء إشكالي ومشكوك فيه، أن لا تتضمن أي شيء يضعنا في اضطراب معرفي ويولد نقد المعرفة بكامله. ينبغي علينا أن نبين بأن هذا يصدق على دائرة موضوع الفكرcogitatio.لكن من أجل هذا ينبغي القيام بتفكير أعمق يجعلنا ننجز خطوات هامة نحو الأمام.
إذا لاحظنا عن قرب ما يكون لغزا جدا وما يجعلنا في المأزق عندما نبدأ في التفكير حول إمكان المعرفة، إنما هو التعالي. كل معرفة طبيعية، المعرفة الما-قبل علمية، ولسبب قوي تتموضع المعرفة العلمية بكيفية متعالية. إنها تعتبر الموضوعات موجودة، إنها ترفع من شأن زعم الوصول عن طريق المعرفة إلى أحوال ال-أشياء التي ليست في ذاتها “معطاة بالمعنى الحقيقي”، أي التي ليست “محايثة”لها.
إذا ما لاحظنا عن قرب هذا التعالي فإننا نجد بأن له معنى مزدوج.فإما أن نفهم من ذلك،أن لا يكون موضوع المعرفة متضمنا-فعليا في فعل التعرف،بحيث أنه بكونه”معطى بمعنى حقيقي”(أو”معطى بكيفية محايثة” أي أن يكون [الموضوع ] متضمنا بالفعل فيه) فعل التعرف،الفكر cogitatio يتضمن لحظات فعلية ،لحظات تكونه بالفعل،لكن الشيء الذي يستهدفه والذي يزعم إدراكه والذي يتذكره،الخ،لا يوجد فعليا كجزء في الفكر cogitatio نفسه،مفهوما كمعيش،لا يقوم فيه كشيء يوجد فيه بالفعل.السؤال سيكون إذن هو:كيف يمكن للمعيش تقريبا أن يخرج إلى ما وراء ذاته؟المحايث يدل إذن هنا على المحايث بالفعل في المعيش المعرفي.
لكن هناك كذلك [نوع ]آخر من التعالي والذي نقيضه هو محايثة مختلفة تماما،أعني الحضور المطلق والواضح،(الحضور-ب-شخصه بمعنى مطلق).إن هذه الكيفية من العطاء، التي تقصي كل شك،يكون لها معنى، وهذا المعنى بصر وإمساك مباشر بالموضوع المستهدف ذاته وكما هو، كيفية تشكل المفهوم الدقيق للبداهة مفهومة كبداهة مباشرة.كل معرفة غير بديهية،معرفة تستهدف وتطرح الموضوع ولا تراه هو نفسه،هي متعالية بالمعنى الثاني.في داخل هذه المعرفة نخرج إلى ما- وراء ما يكون فيها معطى بالمعنى الحقيقي،ما- وراء ما يمكن رؤيته والإمساك به مباشرة.السؤال يطرح هنا هكذا:كيف يمكن للمعرفة أن تعتبر شيئا ما غير معطى فيها مباشرة وحقيقة بأنه موجود؟
من أول وهلة، قبل الدخول بشكل أعمق في تفكير نقد المعرفة فإن هاتين المحايثتين والتعاليين يجدان نفسيهما متداخلين فيما بينهما. فمن الواضح أن الذي يثير السؤال الأول المتعلق بإمكان التعاليات الفعلية هو في الحقيقة يترك الثاني داخلا في اللعبة، ذاك الذي يتعلق بإمكان التعالي فيما-وراء دائرة الحضور البديهي. إنه (أي الذي يثير السؤال) يفترض ضمنيا بأن الحضور الوحيد الذي يكون بحق مفهوما، بدون مشكل وببداهة تامة إنما هو ذاك الذي يكون في اللحظة المتضمنة فعليا في فعل التعرف، ولهذا السبب يعتبر كل ما هو في موضوع معروف غير متضمن في هذا الفعل كملغز، كإشكالي فعليا. (سوف نرى قريبا بأن هذا خطأ قاتل)
لكن سواء فَهِمْنا التعالي في المعنى الواحد أو الآخر، أو في التباس معناه المزدوج، فإنه المشكل الرئيسي والمشكل الموجه لنقد المعرفة، إنه اللغز الذي يحول دون سير المعرفة الطبيعية ويشكل مبررا لأبحاث جديدة. يمكننا أن نعتبر في البداية حل هذا المشكل بأنه هو مهمة نقد المعرفة وبذلك نقوم مؤقتا بالتحديد الأول للشعبة الجديدة، بدلا من أن نعين بكيفية عامة جدا مشكل ماهية المعرفة عموما كتيمة لها.
والحال أنه في اللحظة الأولى لتشييد هذه الشعبة يكمن اللغز، وإذن فإن ما يمنع من اعتبار ما يكون معطى من قبل يجد الآن نفسه محددا بشكل أدق. ينتج عن هذا أنه لا شيء متعال يمكن أن يستخدم كمعطى من قبل. (إذا لم أفهم كيف يمكن للمعرفة أن تصل إلى شيء ما متعال عليها فإنني لن أعرف كذلك فيما إذا كان ممكنا) إن الطريقة العلمية في تأسيس وجود متعال لم تعد الآن تفيدني في شيء. لأن كل طريقة غير مباشرة في التأسيس تحيل إلى الطريقة المباشرة، واللغز يكون متضمنا من ذي قبل في ما هو مباشر.
لكن أحدا ربما سوف يقول: سواء كانت المعرفة مباشرة أو غير مباشرة فإنها تتضمن لغزا، فهذا أكيد. لكن الكيف le commentهو الذي يكون ملغزا، في حين أن إنle que هو الذي يكون أكيدا بشكل مطلق، فلا إنسان عاقل يشك في وجود العالم، وأن الريبي هو نفسه تكذبه ممارسته. جيد، سوف نرد عليه الآن بحجة أقوى تذهب بنا بعيدا. إنه يبرهن فعلا بأنه يمنع اللجوء، بأي وجه كان، إلى محتوى العلوم الطبيعية، العلوم المموضعة بكيفية متعالية، ليس فقط عند بداية نظرية المعرفة، وإنما حتى خلال تفاصيلها اللاحقة. إنه يبرهن بالتالي على الأطروحة الأساسية من أن نظرية المعرفة لا يمكنها أبدا أن تقام على علم طبيعي من أي نوع كان. نتسائل إذن: ما الذي يريد المعارض لنا أن يفعله بمعرفته المتعالية؟ إننا نضع أمامه حصيلة الحقائق المتعالية للعلوم الموضوعية، ونفترض بأنها لم تتضرر في قيمتها كحقيقة من اللغز المثار أمامنا، لغز يتعلق بكيف يكون علم متعال ما ممكنا. ما الذي يريد إذن أن يفهمه بعلمه الواسع، كيف يفهم الانطلاق من إن كي يبلغ كيف؟ إن علمه، من أن المعرفة المتعالية توجد وجودا واقعيا، يضمن له منطقيا بأن المعرفة المتعالية ممكنة. لكن اللغز هو كيف تكون (هذه المعرفة) ممكنة؟ هل على اعتبار أنه يستطيع أن يجد حلا للغز الذي تقوم فيه جميع العلوم، وهي تفترض جميع المعارف المتعالية كيفما كانت؟ لنتأمل: ما الذي ما يزال ينقصه إذن؟ بالنسبة إليه فإن إمكان معرفة متعالية هو فعلا بديهي لكنه بديهي بالضبط بكيفية تحليلية فقط، من جراء أنه يخاطب نفسه (قائلا): يقوم في ذاتي علم يتعلق بالوجود المتعالي. فما ينقصه يكون ظاهرا. إن العلاقة بالتعالي هي التي تكون غامضة بالنسبة إليه. فما يكون غامضا بالنسبة إليه هو الخاصية المنسوبة إلى المعرفة أو إلى العلم، لـ”بلوغ وجود متعال”. أين وكيف يمكنه العثور على الوضوح؟ طبعا يستطيع ذلك إذا كانت ماهية هذه العلاقة معطاة له، في مكان ما، كي يتمكن من رؤيتها، لتجد الوحدة بين المعرفة وموضوع المعرفة، الوحدة التي يشير إليها لفظ “بلغ”، نفسها أمام ناظريه، وبالتالي لا يحصل فقط على علم بإمكانها، وإنما يحصل على هذا الإمكان نفسه في وضوحه الحاضر. في الواقع أن الإمكان نفسه هو الذي يعتبر كشيء ما متعال، كإمكان معلوم ولكنه غير معطى. إن تفكيره، على ما يظهر هو كما يلي: إن المعرفة هي شيء آخر غير موضوع المعرفة؛ المعرفة معطاة لكن موضوع المعرفة غير معطى، المعرفة والحالة هذه تفرض أن ترتبط بالموضوع، بأن تعرفه. كيف يمكنني أن أفهم هذا الإمكان؟ الجواب طبعا هو كما يلي: إنه فقط إذا كان هذا الرابط قابلا بأن يعطي هو نفسه كشيء ما يمكن أن يرى، آنذاك يمكن أن أفهمه. إذا كان الموضوع شيئا متعاليا ويبقى متعاليا، وإذا كانت المعرفة والموضوع منفصلين حقيقة الواحد عن الآخر، فإنه لن يرى هنا بالتأكيد أي شيء، وأن أمله في العثور على طريق يوصله بكيفية ما إلى الوضوح، ربما بواسطة استدلال انطلاقا من بعض القضايا المتعالية، هو بالضبط جنون خالص.
كي يكون منطقيا مع هذا التفكير فإنه يتوجب عليه في حقيقة القول أن يتخلى عن نقطة انطلاقه: يتوجب عليه أن يعرف بأنه في هذه الحالة من الأشياء، تكون معرفة ما هو متعال مستحيلة، وأن ادعاءه معرفته ليس سوى حكم مسبق. المشكل لن يكون إذن هو: كيف تكون المعرفة المتعالية ممكنة، وإنما كيف يمكن تفسير الحكم المسبق الذي يعزي للمعرفة “عملا” متعاليا: إن هذا هو بالضبط طريقة هيوم.
لكن، لنترك هذا جانبا، ولنضف بأن مشكلة كيف (كيف تكون المعرفة المتعالية ممكنة) بل وعموما كيف تكون المعرفة على العموم ممكنة لا يمكنها قط أن تحل بفضل (علم مُعطى مسبقا حول موضوعات متعالية، بفضل قضايا معطاة من قبل) العلوم الدقيقة، من أجل توضيح هذه الفكرة الأساسية لنضف كما قلت ما يلي: إن الأصم منذ الولادة يعلم بأن هناك نبرات وأن النبرات تؤسس إيقاعات، وأن فَنًّا رائعا مؤسس عليها؛ لكن فَهْم كيف تفعل النبرات ذلك كيف تكون الأعمال الموسيقية ممكنة، فإن هذا بالنسبة إليه مستحيل. إن هذا هو بالفعل شيء ما لا يمكنه أن يتمثل له، يعني لا يمكنه أن يراه وأنه لا يمكن أن يمسك في هذه الرؤية عن الكيف. فعلمه المتعلق بالوجود لا يساعده في شيء، وسيكون من العبث أن يتشبث باستنباط كيف الفن، الموسيقي، انطلاقا من علمه هذا وبأن يسعى إلى توضيح إمكانات هذا الفن انطلاقا من معلوماته هو. أن يتم الاستنباط انطلاقا من موجودات معلومة فقط وغير مرئية، فإن هذا غير صحيح. فِعْلُ البَصَرِ لا يترك نفسه يبرهن عليه أو يستنبط من شيء ما. إنه على ما يبدو من باب اللا-معنى أن تكون هناك رغبة في إبراز إمكانات ما (وهذا كذلك بالنسبة لإمكانات مباشرة) بواسطة استنباط منطقي انطلاقا من معرفة غير حدسية. أستطيع، إذن، أن أتيقن كلية بأن هناك عوالم متعالية، أستطيع أن أترك تماما محتوى جميع العلوم الطبيعية: فلا أستعير أي شيء من هذه العلوم. لا ينبغي علي أبدا أن أتخيل بأنني يمكن أن أصل، عن طريق الافتراضات المتعالية والاستدلالات العلمية، إلى حيث أريد أن أصل إليه عن طريق نقد المعرفة: يعني أن أمسك بالبصر إمكان الموضوعية المتعالية للمعرفة. وهذا يَصْدُق على ما يظهر ليس فقط على بداية نقد المعرفة وإنما كذلك على تفاصيلها بمقدار ما تتمسك بمشكلة إبراز كيف تكون المعرفة ممكنة. وهذا يَصْدق أيضا على ما يبدو على مشكل الموضوعية المتعالية وعلى إظهار كل إمكان.
إذا ما ربطنا بهذا [الذي قيل] المَيْلَ القوي الذي لدينا في جميع الحالات التي يتحقق فيها فعل تفكير متعال، وحيث يتعلق الأمر بإقامة حكم على قاعدة هذا الفعل، بأن نحكم في المعنى المتعالي وبأن نسقط،من تم،في μετάδασις εις αλλο γέυος، فإنه ينتج عن هذا الاستنباط الكافي والتام للمبدأ المعرفي التالي في كل بحث معرفي، سواء تعلق بهذا النّمط من المعرفة أو ذاك، ينبغي إنجاز الاختزال الغنوصيولوجي، يعني تسجيل كل تعال يكون داخلا في اللعبة، مؤشر الوضع خارج التيار، أو مؤشر اللامبالاة، بطلان معرفي، مؤشر يقول هذا الذي يلي: إن وجود جميع هذه المتعاليات،سواء كنت أومن بها أم لا،وجود لا يهمني هنا في شيء، فالأمر هنا لا يتعلق بإصدار حكم بصددهذه المتعاليات فكل هذا يبقى كلية خارج اللعبة.
ترتبط جميع الأخطاء الأساسية لنظرية المعرفة بما يطلق عليه اسم. μετάδασις (الخطأ الأساسي للنزعة السيكولوجية من جهة، ومن جهة أخرى خطأ النزعة الأنتربولوجية والنزعة البيولوجية). إن لها آثارا خطيرة جدا لأن المعنى الحقيقي للمشكل لم يخرج قط إلى حيز الوضوح، وأنه في هذه الميتافيزيقا، يضيع تماما، في جزء منه كذلك، لأنه، حتى ذاك الذي يسعى إلى جعل هذه المشكلة واضحة، لا يجعل هذا الوضوح فعالا، ولا يحافظ عليه إلا بصعوبة، وأنه عندما يتراخى فكره يضيع مرة أخرى، فلا نعود نستطيع أن نطرح المشكل بسهولة في كيفيات التفكير والحكم بشكل طبيعي، وكذلك في جميع الكيفيات الخاطئة والمضلة لطرح المشكل والتي تتولد في ميدانه.
Edmund Husserl, Lidée de la Phénoménologie, Cinq leçons, traduit de l Allemand par Alexandre Lowit, EPIMETHEE Essais philosophiques, Collection fondée par Jean Hyppolite et dirigée par Jean-Luc Marion , PUF 4 édition 1990 Juin.
