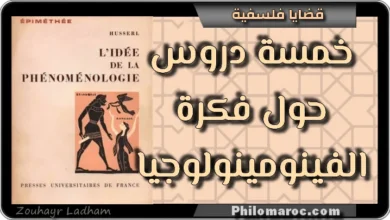إعادة كتابة الحداثة، “جون فرنسوا ليوطار” ترجمة: رضوان شقرون ومنير الحجوجي
السؤال الذي تطرحه التقنيات الجديدة على مسألة إعادة الكتابة كما فكرت فيها هنا هو: إن قبلنا أن تأويل اللانهاية هو قبل كل شيء قضية متعلقة بالخيال الحر وأنه يفرض انتشارا للزمن بين "ليس بعد" و"انتهى للتو" و"الآن"، فعما يمكن أن يحافظ عليه في مواجهة استعمال التقنيات الحديثة؟ كيف يمكن لنا أن ننفلت من قانون المفهوم وإعادة التذكر والتنبؤ؟
إعادة كتابة الحداثة، “جون فرنسوا ليوطار” ترجمة: رضوان شقرون ومنير الحجوجي
يدافع ليوطار في هذا النص الحاسم –الجذري بشكل هادئ- على موقع جديد ضمن تصورات إعادة كتابة الحداثة الإبيستمولوجية بما هي مجاوزة للميتافيزيقا. يناقش ليوطار طرحين أساسيين في تصور إعادة الكتابة هذه: طرح المجاوزة كما هو مع هايدغر وفرويد وماركس ونتشه، وطرح مجاوزة المجاوزة كما هو عند بودريار. يعتبر ليوطار أن مجاوزة الميتافيزيقا تحققت داخل أرض الميتافزيقا، وأن مجاوزة المجاوزة لا زالت محكومة بالأنطولوجيا السرية للميتافيزيقا. يستثمر ليوطار في بنائه لأنطولوجيا للتفادي (تفادي الميتافيزيقا والمجاوزة ومجاوزة المجاوزة) مفهوم فرويد حول لا نهائية التأويل، وهو التأويل الذي يذيب ذاته في صلب ما يبغي تأويله أو إعادة كتابته. وتنجم الأنطولوجيا المحركة لهذا التصور من وضع ليوطار للجميل (أي للذي، خلافا للإبستمولوجي والسياسي، يفرض لا نهائية تأويلية) في جذر الفكر والمعنى والتأويل.
النـــص
هذا العنوان (إعادة كتابة الحداثة) كان قد اقترحه علي كل من كاتي و ودوورد وكارول تينيزون من معهد دراسات القرن العشرين في ميل ووكي وإني أشكرهما على ذلك. ويبدو لي حقا أفضل بكثير من العناوين المألوفة مثل “ما بعد الحداثة” و”ما بعد الحداثية” و”ما بعد حداثي” التي نأطر بها هذا النوع من التفكير. تتمثل ميزة هذا الاختيار في تحويلين اثنين: تحويل الزائد “بعد” إلى “إعادة” في ما يخص المعجم والتطبيق التركيبي للزائد المحول على فعل “كتب” وليس على الاسم “الحداثة”.
يشير هذا التحويل المزدوج إلى مسارين أساسيين. إنه يظهر إلى أي حد يكون تحقيب التاريخ الثقافي من خلال “الماقبل” و”الما بعد” عديم الفعالية بسبب كونه لا يخضع وضعية “الآن” للتساؤل، هذا الآن الذي يكون من المفروض انطلاقا منه اتخاذ زاوية شرعية للنظر حول التوالي الكرونولوجي. بالنسبة لفيلسوف “قاري” شيخ مثلي يحيل هذا المعطى إلى تحليل أرسطو للزمن في الكتاب الرابع من الفيزياء. يشير أرسطو إلى أنه من المستحيل تحديد الفرق بين السابق واللاحق دون وضع مجرى الأحداث في علاقة “بالآن”. ولكن ليس أقل استحالة في الوقت ذاته الاستحواذ على هذا “الآن”. بما أنه لا يتوقف عن التلاشي بفعل الانجذاب من قبل ما نسميه مجرى الوعي وسيرورة الحياة والأشياء والأحداث إلى درجة نكون فيها دائما متقدمين أو متأخرين في الوقت ذاته عندما نريد إحكام القبضة على شيء كهذا “الآن” بشكل دقيق. يشير “بعد فوات الأوان” إلى تضخم في الزوال ويشير التأخر إلى تضخم في القدوم. تضخم في ماذا؟ في نية تحديد مشروع القبض على “موجود” يكون “هنا والآن”، يكون الشيء ذاته. إذا طبقنا هذا التحليل على الحداثة، فإن لا الحداثة ولا ما يسمى ما بعد الحداثة يمكن تحديدهما كحقب تاريخية واضحة تكون ما بعد الحداثة فيها شيئا يأتي “بعد” الحداثة. يجب القول على العكس من ذلك إن ما بعد الحداثي محايث للحداثي بما أن الحداثي، الزمنية الحديثة تحمل في ذاتها رغبة في الخروج من ذاتها داخل حالة أخرى وليس فقط التوجه نحوها ولكن الذوبان فيها تماما كالمشروع اليوطوبي وأيضا كل مشروع منخرط في المحكيات الكبرى للانعتاق. يجب القول بشكل حاسم ولا رجعة فيه إن الحداثة منتفخة بما بعد حداثتها.
إن ما يتعارض مع الحداثة ليس ما بعد الحداثة ولكن العصر الكلاسيكي. يتوفر هذا الأخير بالفعل على حالة للزمن أو فلنقل على وضع للزمنية يتم تناول المستقبل والماضي فيه كما لو أنهما، وقد تم تناولهما معا، يحتويان كلية الحياة في وحدة واحدة للمعنى. إن هذه مثلا ربما هي الطريق التي تنظم وتوزع بها الأسطورة الزمن.
من وجهة النظر هذه نلاحظ أن تحقيب التاريخ هو وضعية خاصة بالحداثة.
يشكل التحقيب طريقة لوضع الأحداث في توالي: يكون فيه هذا الأخير موجها من قبل مبدأ الثورة. إن الحداثة في ما تعد بتجاوز ذاتها مدعوة لوسم وتأريخ نهاية فترة وبداية فترة أخرى. من الملائم، بما أننا نفتتح عصرا نصفه بالجديد كلية، وضع عقارب الساعة في نقطة الصفر. يشير فعل الافتتاح هذا في المسيحية والديكارتية واليعقوبية إلى العام الأول (الوحي والتوبة في المسيحية والنهضة والتجديد في الديكارتية واستعادة الحريات في اليعقوبية).
تشير هذه الجوانب الثلاثة “للإعادة” إلى مظهر أساسي في مسألة إعادة الكتابة. وهذا هو المسار الثاني الذي يشير إليه التحويل الذي أعلنت عنه سابقا. إن غموض “إعادة الكتابة” هو نفسه الذي يسم علاقة الحداثة بالزمن.
يمكن لإعادة الكتابة أن تعني كما أوضحت ذلك في السابق إعادة عقارب الساعة إلى نقطة الصفر، أي ذلك الفعل الذي يقوم بمحو ما سبقه وبالانفتاح بالتالي على زمن جديد. يشير هذا الاستعمال “للإعادة” إلى عودة إلى بداية متخلصة من كل ما قبل أحكام لأننا نتصور أن هذه الأخيرة تنتج فقط عن مخزون وتراث الأحكام اعتبرناها صحيحة يوما ما بدون أن نعيد فحصها. إن الرهان بين “الماقبل” و”الإعادة” بمعنى العودة يتمثل في محو “الما قبل” المتضمن على الأقل في بعض من تلك الأحكام القديمة. بهذا المعنى يجب أن نفهم مثلا تسمية “ما قبل التاريخ” التي أعطاها ماركس لكل التاريخ البشري السابق على الثورة الاشتراكية المنتظرة والتي يقوم ماركس بتحضيرها.
يمكننا الآن أن نوضح معنى ثان لهذه “الإعادة”. لا تعني هذه الأخيرة في ارتباطها بشكل حاسم بالكتابة عودة نحو البداية ولكن بالأحرى ما سماه فرويد “تأويل اللانهاية”، أي ذلك العمل الذي يهدف فيما يخص الحدث ومعنى الحدث إلى التفكير فيما يحتجب عنا ليس فقط بسبب الحكم السابق ولكن أيضا بسبب تلك الأبعاد الخاصة بالمستقبل المتمثلة في المشروع والبرنامج والمستقبلية والخطاب التحليل–نفسي ذاته.
في نص قصير ولكن أساسي متعلق “بالتقنية” التحليل-نفسية، يميز فرويد بين التكرار والتذكر وتأويل اللانهاية. ينتج التكرار الذي هو معطى عصابي أو هذياني عن “نظام” يمكن الرغبة اللاواعية من التحقق وينظم وجود الذات على شكل دراما.
في هذا الصدد يكون المصير هو الشكل الذي تتخذه حياة المريض المحكومة بقانون الرغبة كما هي “مبنينة”. نعلم أن قصة أوديب شكلت النموذج بالنسبة لفرويد. في هذا التصور للمصير تتوحد بداية ونهاية القصة وهو ما يجعل القصة خاضعة لنظام كلاسيكي للزمن حيث الآلهة، كما كتب هولدرلين، لا تتوقف عن التدخل في بنية مسارها.
يحدد نظام الرغبة كما صاغه وحي أبولون بشكل مسبق الأحداث الكبرى التي سيعيشها خلال قصته. وهنا تبدو حياة الملك كما لو أنها مختومة، بما أن المستقبل يعلن عنه في الماضي الذي يجهله أوديب ويقوم بالتالي بتكراره.
ولكن الأمور ليست بهذا الوضوح تماما. في تراجيديا سوفوكل كما في التحليل الفرويدي يرغب المريض في أن يعي ويكشف السبب وراء الاضطراب الذي يعاني منه والذي عانى منه طيلة حياته، إنه يريد أن يتذكر وأن يقوم بلم شتات الزمنية المنفلتة والمشتتة. إن الطفولة هو الاسم الذي يتخذه هذا الزمن الضائع. في نص سوفوكل يقوم الملك أوديب بالبحث في أصل الخطيئة التي هي ربما سبب الطاعون الذي ضرب المدينة. ويبدو أن المريض وهو ملقى فوق السرير ينخرط في بحث مماثل. إننا نقوم هنا بإنشاء القضية حيث نستدعي الشهود ونجمع المعلومات كما في الروايات البوليسية. بهذه الطريقة تتأسس حبكة من مستوى ثان تقوم بمضاعفة قصتها الخاصة داخل الحبكة الأولى موضوع العلاج.
عادة ما تفهم “إعادة كتابة الحداثة” بهذا المعنى أي بمعنى التذكر كما لو أن الأمر يتعلق بالكشف عن جرائم وخطايا وكوارث النظام الحديث وبالتالي الكشف عن مصير يكون وحي ما في بداية الحداثة قد حضره وحققه في تاريخنا. إننا نعرف إلى أي مدى هو خادع هذا الفهم لإعادة الكتابة. يتمثل الخداع في أن التحقيق في أصول المصير يحدده المصير ذاته وأن مسألة بداية الحبكة لا تطرح في نهايتها إلا لأنها تشكل نهاية الحبكة. يتحول البطل هنا إلى مجرم وقت ما يكشف عنه المحقق. لهذا السبب ليست هناك “جريمة كاملة”، أي جريمة يمكنها أن تبقى مجهولة إلى الأبد. فلا يكون سر ما سرا “حقيقيا” إذا لم يكن الجميع يعرف طبيعته كسر. لكي تكون جريمة ما كاملة يجب أن تعرف وتفهم بوصفها كذلك، ولهذا السبب بالذات تتوقف عن كونها كاملة.
بعبارة أخرى نقول، على طريقة جون كاج، إنه لا يوجد صمت لا يمكن أن يسمع بوصفه كذلك وبالتالي ليس هناك صمت لا يمكنه أن يحدث صوتا ما. هناك في العمق حبكة واحدة تقوم بنسج علاقة حميمية بين الصوت والصمت والمجرم والشرطي واللاوعي والوعي.
إذ فهمنا “إعادة كتابة الحداثة” على هذا النحو أي بوصفها بحثا وتعيينا وتسمية للوقائع المحتجبة التي نتخيلها في أصل الشرور التي نعاني منها، أي نفهم إعادة كتابة الحداثة كمسار للتذكر، فإننا نقوم بتكريس وتنفيذ الجريمة من جديد عوض أن نضع حدا نهائيا لها. بالفعل، فعوض إعادة كتابة حقيقية للحداثة مع افتراض أن ذلك ممكن فإننا لا نقوم في العمق إلا بكتابة وتحقيق الحداثة ذاتها لأن الكتابة هي دائما إعادة –للكتابة. إن الحداثة تنكتب، تضاعف ذاتها داخل إعادة-كتابة دائمة. سأمثل لهذه الخدعة بمثالين. يكشف ماركس عن المنطق الخفي للرأسمالية. ويضع القضاء على الاغتراب الخاص بقوة العمل في قلب مسار التحرر وبناء الوعي. لقد اعتقد ماركس أنه قام بكشف وفضح الجريمة الأصلية في أصل شر الحداثة (يتعلق الأمر باستغلال العمال). واعتقد كذلك كمحقق شرطة أنه بالتعرية عن الواقع سيمكن البشرية من الخروج من طاعونها الكبير. إننا نعرف اليوم أن ثورة أكتوبر تحت غطاء الماركسية وفي العمق كل ثورة أخرى لم تقم ولن تقوم إلا بإعادة فتح الجرح ذاته: يمكن للتعيين وللتشخيص أن يتغيرا ولكن المرض نفسه يعاود الظهور داخل إعادة الكتابة هذه. لقد اعتقد الماركسيون أنهم قضوا على اغتراب البشر، ولكنهم لم يقوموا إلا بتحويل هذا الاغتراب من مكانه.
نقترح الآن التوجه نحو الفلسفة. لقد حاول نيتشه تحرير الفكر وطريقة التفكير من قبضة ما سماه الميتافيزيقا، أي ذلك المبدأ الذي يشير منذ أفلاطون وحتى شوبنهاور إلى القضية الأساسية الوحيدة بالنسبة للبشر المتمثلة في الكشف عن الأساس الذي يمكنهم من التحدث بشكل ملائم مع الحقيقة، ومن الفعل وفقا للخير والعدل. إن الطرح الأساسي عند نيتشه هو الاستحالة الجذرية لأي “وفقا لـ” نظرا لاستحالة المبدأ الأول أو الأصلي، تماما كما طرحت ذاتها فكرة الخير عند أفلاطون أو مبدأ العلة الكافية عند لايبنز. إن كل خطاب بالنسبة لنتشه بما في ذلك خطاب العلم أو الفلسفة يجب أن ينظر إليه كمنظور. ولكن نيتشه يسرع بدوره إلى تعيين ما يؤسس المنظورات ذاتها في ما يسميه إرادة القوة. تعيد فلسفته بذلك إنتاج الطرح الميتافيزيقي وتحقق أكثر من ذلك وبشكل دوغمائي ومتكرر جوهر الميتافيزيقا لأن ميتافيزيقا الإرادة التي ينهي بها فلسفته هي ذاتها التي تحويها الأنظمة الفلسفية للغرب الحديث. وهو ما يوضحه هايدجر.
تكرر إعادة الكتابة النتشوية رغما عنها الخطأ ذاته وهو ما يدفعنا للتفكير في إعادة للكتابة تنفلت أكثر ما يمكن من تكرار ما تعاود-كتابته. لقد شكلت الإرادة ذاتها ربما أساس فعل التذكر. وهو ما حاول فرويد تبيانه عندما ميز تأويل اللانهاية عن التذكر. عندما نتذكر فإننا نريد دائما أكثر، نريد الاستحواذ على الماضي والقبض على ما حدث فيه، إننا نريد التحكم في الجريمة الأصلية المفقودة وعرضها وإظهارها كما لو أنها قابلة لأن تفصل عن سياقها الفعلي وعن إيحاءات الخطأ والخجل والغرور والقلق التي ما زالت تغمرنا في حاضرنا والتي تحكم فكرتنا حول فكرة الأصل.
إننا ننسى، عندما نحاول البحث عن سبب أصلي كما هو الشأن بالنسبة لأوديب، أن إرادة تعيين أصل الشر تحكمها الرغبة لأن جوهر الرغبة أن ترغب في الخروج عن ذاتها بما أن الرغبة شيء لا يطاق. نعتقد بذلك أننا نضع حدا للرغبة ونحقق نهايتها (هذا هو غموض كلمة نهاية في الفرنسية حيث تشير في الوقت ذاته إلى الهدف والتوقف: إن هذا الغموض هو نفسه الذي يسم الرغبة). إننا نحاول أن نتذكر، وهذا يشكل على الأرجح وسيلة جيدة لأن ننسى أكثر.
وإذا كان صحيحا أن المعرفة التاريخية تفرض أن يكون موضوعها مفصولا عن أي استثمار ليبيدي خاص بالمؤرخ، فمن اليقيني أننا بهذه الطريقة في كتابة التاريخ نتجه نحو “اختزاله”. وهذا ما تشير إليه الكلمة اللاتينية redigere والكلمة الإنجليزية putting down: الوضع عن طريق الكتابة والسحق. تشير writing down هي كذلك إلى التسجيل والتدوين. إننا نجد هذا النوع من إعادة الكتابة في أكثر من نص تاريخي وهو ما يتناوله نيتشه في تأملات غير راهنة عندما يسائل ويفضح الفخ الذي يحكم البحث التاريخي.
إن الوعي بهذا الفخ، بدون شك، هو الذي دفع فرويد إلى التخلي عن فرضيته حول أصل العصاب. في أبحاثه الأولى، أرجع فرويد هذا الأصل إلى “مشهد أولي”، وهو مشهد إغراء الطفل من قبل البالغ. وبعد تخليه عن نزعته الواقعية فيما يخص البدايات انفتح فرويد في الجهة الأخرى للتحليل النفسي، أي في جهة نهايته، على فكرة أن فعل العلاج يمكن، بل عليه أن يكون لا نهائيا. خلافا للتذكر، يكون تأويل اللانهاية نوعا من العمل بدون نهاية وبالتالي بدون إرادة: بدون نهاية بمعنى أنه غير موجه من قبل مفهوم الهدف، ولكن هذا لا يعني أنه ليس بدون غاية. في هذه الحركة المزدوجة في اتجاه الخلف والأمام يظهر التصور الأكثر ملاءمة لإعادة الكتابة. نعلم أن فرويد يلح بشدة على القاعدة المسماة “الانتباه العائم المتساوي”، وهي القاعدة التي على المحلل احترامها تجاه المريض. تشير هذه القاعدة إلى ضرورة إعطاء نفس الأهمية لكل ما ينتجه المريض من كلام حتى وإن بدى تافها أو دون قيمة. تقول القاعدة ما مجمله: لا يجب إصدار حكم مسبق، يجب تعليق الحكم وجمع المعلومات وإعطاء الأهمية ذاتها لكل ما يأتي من المريض دون التدخل فيه. من جهته، على المريض أن يحترم وضعا مماثلا: عليه أن يترك كلامه طليقا وأن يترك “الأفكار” والصور والمشاهد والأسماء الجمل تأخذ مجراها كما تنتج على لسانه وعلى جسده، “في فوضاها” دون أن يخضعها لاختيار أو قمع.
تفرض هذه القاعدة على الفكر أن يتحلى بالصبر بمعنى جديد، ليس بمعنى أن يتحمل بشكل سلبي وتكراري نفس الرغبة القديمة والراهنة ولكن بمعنى تنفيذ قابليته الخاصة للتأثر على ما يقبل نحو عقله وجعل ذاته ساحة للأحداث التي تأتيه من شيء ما يجهله. يسمي فرويد هذا الموقف التداعي الحر وهو ليس إلا طريقة لربط جملة بأخرى دون الأخذ بعين الاعتبار القيمة المنطقية والأخلاقية والجمالية للربط.
سوف تتساءلون عن العلاقة الممكنة بين هذه الممارسة وإعادة كتابة الحداثة. أذكر بأن الخيط الرابط الوحيد الذي نتوفر عليه في تأويل اللانهاية يتمثل في الإحساس أو فلنقل في الإنصات إلى الإحساس. عندما تأتينا شذرة من جملة ومقطع من معلومة وكلمة فإننا نربطها في الحال “بوحدة” أخرى، دون المرور بأي تفكير أو تدليل أو وساطة. عندما نقوم بذلك فإننا نقترب شيئا فشيئا من مشاهد ما، من مشهد متعلق بشيء ما. نصفه. نجهل ما هو. نعرف فقط أنه يحيل على ماض هو في الوقت ذاته أكثر بعدا وأكثر قربا. إن الأمر يتعلق بماضي الذات وماضي الآخرين في الحين نفسه. إن الزمن المفقود لا يتم تمثيله كما هو الأمر في لوحة، بل لا يتم عرضه على الإطلاق. إنه ما يعرض عناصر لوحة، لوحة مستحيلة. أن نقوم بإعادة الكتابة هو أن نقوم بتسجيل هذه العناصر..
من الواضح أن إعادة الكتابة هذه لا تمنحنا أية معرفة عن الماضي. وهو ما اعتقده أيضا فرويد. إن التحليل النفسي ليس مرتبطا ولا متعلقا بمعرفة ولكن “بتقنية”، بفن. ليس مطلوبا من التحليل النفسي أن يعطي تعريفا لعنصر ماضي. إنه يفترض على العكس من ذلك أن الماضي ذاته هو الفاعل الذي يمنح للفكر العناصر التي يبني بواسطتها المشهد. ولكن هذا المشهد بدوره لا يزعم بتاتا أنه يعكس بشكل وفي ما يسمى “المشهد الأصلي”. إنه جديد بما هو موضوع إحساس جديد. نقول عما مضى فيه إنه حاضر هنا والآن، قوي جدا، على قيد الحياة. إنه ليس حاضرا كموضوع، هذا إذا كان بإمكان الموضوع أن يحضر، ولكنه حاضر كنسيم، كتلميح. يشتغل البحث عن الزمن الضائع ونص المعنى الأحادي والطفولة البرلينية لبينيامين وفق هذه التقنية (دون أن تختزل فيها بطبيعة الحال). سأبدو ربما غريبا وأقول إن تقنية الانتباه العائم المتساوي حاضرة في نص المحاولات لمونطاني.
سأدلي بملاحظات ثلاث على سبيل خاتمة غير ممكنة. أولا وحتى لو أن فرويد اعتقد أن هذه “التقنية” شكلت فنا كما تشير إلى ذلك الكلمة اليونانية تيخني، فإنه انتبه مع ذلك إلى أنها شكلت عنصرا أساسيا في مسار الانعتاق. بفضلها بالفعل يمكن تفكيك اللاوعي والمجموعات ما قبل المنظمة للدوال التي تشكل الترسانة العصابية أو الذهانية التي تبنين حياة الذات كمسار. لا يبدو لي أن هذه الفرضية جيدة. عندما وصفت بشكل مختصر ما أعنيه بإعادة الكتابة كانت تشغلني فكرة من المستحيل أن أطورها هنا. سأكتفي بالإشارة إلى أي مدى هذا الوصف لإعادة الكتابة قريب جدا من تحليل كانط لعمل الخيال في الذوق، في لذة الجميل. إن تصوري وطرح كانط يعطيان الأهمية ذاتها للحرية التي يتم بها تلقي العناصر التي يمنحنا إياها الإدراك، وكلاهما يلحان على أن الأشكال الخاصة باللذة الخالصة الجمالية أو الخاصة بالتداعي والإنصات الحرين يمكن أن ينشأ بعيدا عن كل منفعة تجريبية أو ذهنية. إن جمال الظاهرة مرتبط بسيولتها وحركيتها وتلاشيها وهو ما يوضحه كانط من خلال استعارتي اللهيب الصاعد من داخل المدفأة والرسم المتلاشي الذي تخطه المياه المتدفقة للنهر. ويختم كانط بقوله: “إن الخيال يعطي للعقل مجالا للتفكير” أكثر مما يمنحه العمل المفهومي للفهم. لهذه الأطروحة كما نرى علاقة بمسألة الزمن كما طرحتها في البداية. إن التناول الجمالي للأشكال لا يكون ممكنا إلا إذا تخلينا عن إرادة في التحكم في الزمن من خلال تركيب مفهومي لأن الأمر لا يتعلق “بإعادة تذكر” للمعطى كما يقول كانط ولكن بالقدرة على ترك الأشياء تقبل كما هي. وفقا لهذا التصور تكون كل لحظة وكل آن عبارة عن “انفتاح على”. يدعم هذا الطرح كل من تيودور أدرنو وأرنست بلوخ خاصة Spuren هذا الأخير، ويشير أدرنو في نهاية الجدلية السالبة وأيضا في النظرية الجمالية التي بقيت غير مكتملة إلى ضرورة إعادة كتابة الحداثة مع الإلحاح على أن الحداثة هي إعادة كتابتها الخاصة وأنه لا يمكن إعادة كتابتها إلا في صيغة ما يسميه “دراسات صغرى” والتي تذكر بدون شك بـ”مقاطع” بنيامين.
لقد أشرت إلى الخصائص التي تجمع بين اللعب الحر للخيال الجمالي والتداعي أو الانتباه الحرين للعلاقة التحليلية. ولكن علينا أيضا أن نشير إلى الاختلاف بينهما. باختصار سأشير إلى الاختلافات الأساسية.
أولا، لا تشكل اللذة التي يمنحها الجميل موضوعا لبحث ما، إنها تدرك أولا تدرك ولا علاقة لها بإرادة الفنان في خلق أثر للذة من خلال عمله. إن الفنان لا يكون مبدأ لأثر الذوق هذا. إن اللغة الجمالية “تنزل” على العقل كنوع من الرحمة، “كإلهام”. على العكس من ذلك يكون خطاب المريض عملا، تأويلا لا نهائيا، “حرا” في ما يخص وسائله ولكنه مشروط بغاية محددة. هذه الأخيرة ليست بطبيعة الحال متعلقة بمعرفة ما، إنها مقاربة “لحقيقة” أو “لواقع” يقع خارج دائرة الفهم.
وإن كان الأمر كذلك ثانيا فلأن العمل التحليلي يسمه ألم شديد يضع الذات في حالة انفصال عن ذاتها، ويجعل هذا الانفصال في الوقت ذاته يتكرر بشكل لا نهائي. سيكون من الخطأ هنا الاعتقاد أن بإمكان العلاج أن يصالح الوعي واللاوعي. عندما أقول إن العلاج لا يمكن أن ينتهي فلأن اغتصاب الذات وخضوعها للتبعية شيئان محايثان لها. إن ما هو عاجز عن النطق يبقى غير قابل للاختزال. على العكس من ذلك تكون لذة الجميل كما عند شتاندال وأدرنو “وعدا بالسعادة” أو كما عند كانط تذاوتا إحساسيا يخص علاقة الذات بذاتها وبالآخرين.
أخيرا، وبما أن هناك جمالية للمتسامي ناتجة عن تمطط الأشكال الجميلة إلى درجة تحولها إلى ما هو “بدون شكل” (كانط)، والتي لهذا السبب بالذات تدفع نحو قلب وتحطيم جمالية الجميل، يجب، تبعا للأطروحة الفرويدية، فصل ما يسميه لا كان الشيء وفرويد المؤثر اللاوعي اللذين لا يقبلان أبدا التمثيل عن الكبت الثانوي المنتج “لتشكيلات” الحلم والعرض والفعل الفاشل الخ..، وهي كلها تمثلات اللاوعي على هامش ساحة الوعي. إن الكبت الأصلي الملتصق بشكل حميمي بهذا الشيء يشكل بالنسبة للكبت الثانوي ما يشكله المتسامي بالنسبة للجميل. تتعلق إعادة الكتابة كما أفهمها بطبيعة الحال بالسوابق المرضية للشيء، ليس فقط بالشيء بوصفه مقدمة لتشكل فرادة ولكن بالشيء الذي يلازم “اللغة” والتراث والمادة التي نكتب بها وضدها وداخلها. لذلك تكون إعادة الكتابة شأنا خاصا بالمتسامي وكذا بالجميل بشكل أكثر وضوحا. وهو ما تطرحه بشدة مسألة العلاقات بين الجمالي والأخلاقي.
إن ملاحظتي الثانية بسيطة جدا. فما سمي هنا بإعادة الكتابة ليست له أية علاقة بطبيعة الحال، لا بما يسمى ما بعد حداثة أو ما بعد حداثية في حقل الإيديولوجيات المعاصرة ولا باستعمال السخرية والاستشهاد بأعمال حديثة أو حداثية كما هو الشأن في المعمار والتشكيل أو المسرح. كما أن الأمر لا يتعلق بذلك الاتجاه في الأدب الذي يعود نحو الجمالية الأكثر تقليدية في الحكي أي نحو الأشكال والمضامين. لقد استعملت بنفسي كلمة “ما بعد حداثي”. إنها كانت طريقة لإثارة ووضع النقاش حول المعرفة في دائرة الضوء. إن ما بعد الحداثة ليست عصرا جديدا، إنها إعادة كتابة بعض الخصائص التي تنادي بها الحداثة ومنها بشكل خاص إرادتها في تأسيس شرعيتها حول مشروع تحرير البشر عن طريق العلم والتقنية. ولكن إعادة الكتابة هذه كما قلت سابقا حاضرة ومنذ زمن بعيد في الحداثة ذاتها.
تتعلق الملاحظة الثالثة بالقضايا الناتجة عن الاستثمار الكبير لما يسمى بالتقنيات الحديثة في إنتاج وتوزيع واستهلاك الخيرات الثقافية. ولكن لماذا الإشارة إلى هذه التقنيات هنا؟ لأنها تقوم بتحويل ما نسميه الثقافة إلى صناعة. تبدو هذه الملاحظة عادية جدا ولكن يمكن أن نفهم أيضا هذا التحول كإعادة كتابة. إن إعادة الكتابة كلمة متداولة في اللغة الصحفية وهي تحيل على حرفة قديمة. تتمثل هذه الحرفة بالذات في محو الآثار التي يتم تركها على نص عبر تداعيات غير متوقعة و”متحررة”. لقد أعطت هذه التقنيات الجديدة لهذه الحرفة دفعة كبيرة بما أنها أخضعت للحساب الدقيق كل كتابة مهما كان سنادها، سواء كان صورا مرئية أو صوتية أو كلاما أو خطوطا موسيقية وأخيرا الكتابة ذاتها. بالنسبة لي لا تتمثل النتيجة الخارقة لهذا المسار، كما يعتقد بودريار، في تشكيل شبكة ضخمة من الصور. يبدو لي أن ما هو مزعج حقا هو الأهمية التي يحظى بها مفهوم وحدة المعلومة. لم يعد يتعلق الأمر مع هذه الوحدات بأشكال حرة معطاة هنا والآن للإحساس والخيال. إنها على العكس من ذلك وحدات تنتجها وتحددها مهارة آلة حاسوب وهي محددة على جميع المستويات: المعجمي والتركيبي والبلاغي… الخ –إنها مجمعة في أنظمة تبعا لمجموع إمكانيات (تشكل قائمة) تحت مراقبة صانع برامج. لذلك يكون السؤال الذي تطرحه التقنيات الجديدة على مسألة إعادة الكتابة كما فكرت فيها هنا هو: إن قبلنا أن تأويل اللانهاية هو قبل كل شيء قضية متعلقة بالخيال الحر وأنه يفرض انتشارا للزمن بين “ليس بعد” و”انتهى للتو” و”الآن”، فعما يمكن أن يحافظ عليه في مواجهة استعمال التقنيات الحديثة؟ كيف يمكن لنا أن ننفلت من قانون المفهوم وإعادة التذكر والتنبؤ؟ سأكتفي الآن بالإجابة التالية: أن نعيد كتابة الحداثة هي أن نقاوم كتابة هذه الما بعد حداثة المزعومة